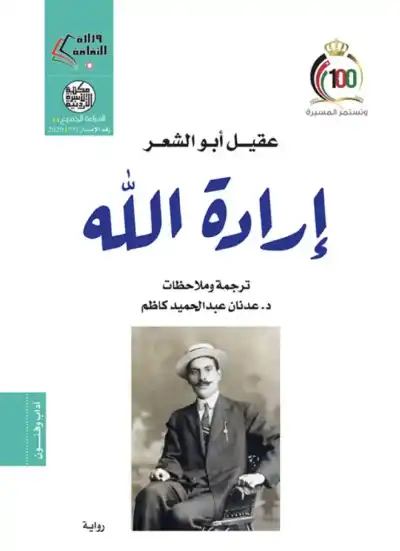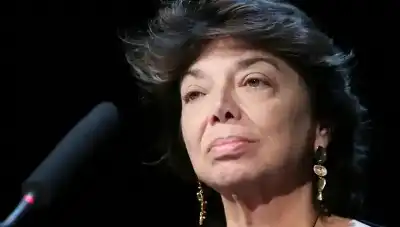مدار الساعة - أيمن ربيع
لستُ من هواة الدراما الصَّعيدية، ولا أحب الطريقة التي يقدمهم بها التلفزيون والمسلسلات. ذلك الوجه الصارم الذي يتوسطه شاربٌ كثيفٌ يغطّي الفمّ أحياناً، العصا التي يُولد بها الجنين الصعيديّ ملتصقةً بِيده، طريقة الكلام التي تدعو للسخرية اللاذعة حتى من الصعايدة أنفسهم.
تخيل صعيديّاً من قِفط في قنا مثلاً، يشاهد الطريقة التي (يتصعْدن) بها أحمد داش، في نسل الأغراب! الجماعات التي يمشون فيها حاملين بنادقهم والذخيرة، حتى لو كان الأمر متعلقاً بزيارة منزلية أو شراء سجائر فرط، وبالطبع ذلك الثأر الضروري الذي تتمحور حوله حياة الناس في الصعيد.
كانت تلك فكرتي الأولى عن الصعيد في صِغري، والتي ثبّتتها مسلسلات الطفولة التي أذكر منها تحديداً وبشكل خاص، مسلسل حدائق الشيطان. تلك الفكرة عن الإنسان الصعيديّ، أنه إنسانٌ عدواني وُلد لأخذ الثأر وفقط. وكأن الوالِدات هناك يلدن ويُرضِعن ويُسمِّنَّ أولادهنّ ليأخذوا بالثأر!
كنت أتخيل الصعيدي- مثلًا- في حالة ملل أو كآبةٍ عابرة، فيقرر أن يقتل أول شخص يقابله في الشارع؛ لتبدأ سلسلة مسلّية ولذيذة من الثارات والمطاردات وذئاب الجبل وحدائق الشيطان ونسل الأغراب، سلسلة تشغله وتشغل أحفاده سنين طويلة بعد ذلك لئلا يصيبهم الملل.
كان إنسان الصعيد مصدر فزعٍ في طفولتي، يأتيني في الكوابيس- جمال سليمان تحديداً- يخرِّب عليَّ نومي، ويسألني: لِمَ قتلت أبي؟ ثأري عندك، سأقتلك، سأقتلك.
عندما رأيت أول إنسانٍ صعيدي على الحقيقة، بعد أن دخلت الجامعة، قتلتني الدهشة.
كنت أتخيل لقائي الأول بإنسانٍ صعيدي- وفق تصوري الطفوليّ- لقاءً غامضاً، يظهر فيه شبحٌ يرتدي جِلباباً وعِمّة وتلفيعة، ثم يزيح اللثام عن وجهه- لأنه متخفٍّ وهاربٌ من الثأر في بلدهم كما تعلم- ويعرّف نفسه بأنه فلان وِلد فلان، ثم ينزل من على مُهرِه أو حِصانه.
لكنني تفاجأت به جانبي في قاعة المحاضرات، يلبس نظارةً ويلبس الجينز ويعرّف نفسه بأنّه فلان الفلاني، بِلا لثامٍ ولا تلفيعة ولا عصاً يتوكأ عليها، كان إنساناً طبيعيّاً يتكلم ويتعامل كالبشر الطبيعيين، بل أكثر طبيعيّة مني. ما هذا بحقّ اللعنة!
صار صديقاً لي، تكلمنا كثيراً، لم ألحظ في لِسانه خللاً ما، تخيل أنه حتى لم يقل "وِلد" أو "واصِل" أو "عاد"، ولا مرّة! كان يحدثني بلهجة قاهرية عادية، وحتى لهجته العادية لا تشبه تلك التي في المسلسلات، لم يكن يتلفتْ أيضاً، أي أنه لم يكن هارباً من ثأرٍ ما.
صار بقية زملائي من الصعيد أصدقاءً لي، بل أصدقاء مُقربين، نأكل ونشرب ونجشأ ونتبادل الأفكار والأقلام والسرائر وأحياناً الأفلام الأجنبية، تصوّر!
في رمضان الماضي، ونحن نتسحّر معاً، كان التلفاز يعرضُ مشهداً من مسلسلٍ يصوِّر صعايدة يقومون بأفعالٍ عاديّة جدًا، بطريقةٍ غريبةٍ جداً، يسيرون في جماعاتٍ من خمسةٍ وعشرين فرداً حاملين بنادق وذخائر، يطلقون النار بسببٍ وبلا سبب، يهرب أحدهم من نافذة البيت- خوفاً من الخمسة وعشرين فرداً الآنِف ذكرهم- فتجده في قلب الجبل، يتنكرُ بحلقِ شنبهِ أو بالتخلي عن عصاه، وأشياء تُضحك من سذاجتها، تُضحك حتى أصدقائي الصعايدة!
لستُ صعيديّاً، وأحيانًا أتمنى لو كنتُ وُلدتُ صعيديّاً لفرط تأثري بأصدقائي من الصعيد، بأخلاقهم ورجولتهم وثقافتهم ومواقفهم التي يُعييني عدُّها، معي على الأقل؛ لذلك أحبُّ أن أحكي عنهم، وأجاورهم وأسامِرهم.
أظنهم يفرحون بذلك، ويقدرون تواجدهم الدائم على ساحة الدراما، ولو بعملٍ واحدٍ كل موسمٍ على أقلِّ تقدير، كمسرحٍ زماني ومكاني لمسلسلاتٍ وأفلامٍ لن تنتهي إلا بنهاية الزمن، أو بنهايةِ تلك العقليات البليدة من الكُتّاب والمخرجين.
لكنني أُقدِّرُ أنهم سيفرحون أكثر حين نحكي عنهم فعلاً، حين نصوّر واقعهم وهمومهم وأحلامهم، حين نبتعد قليلاً عن الثأر والتلفيعة والغِلظة غير المبررة التي يُصورون بها، حين نقدم صعيديّاً اسمه أحمد وحسن، ليس بالضرورة عزام وِلد وهدان أو حسنين وِلد أبو جليل، وحين يُدرك صناع المسلسلات أنه حتى الصعايدة أنفسهم يرون مسلسلاتِهم دراما مزيّفة.
عربي بوست