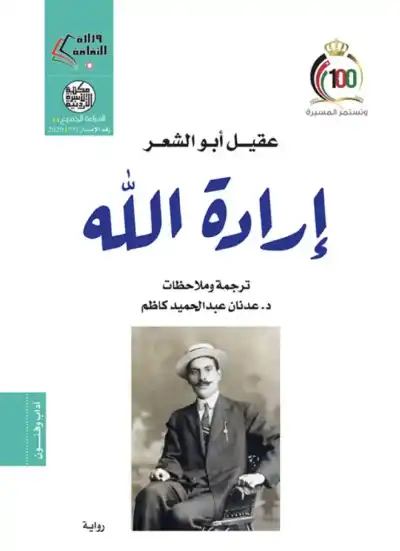مدار الساعة - مع تأكيد القرآن الكريم، في أكثر من موضع، أهميةَ الانتباه إلى سنن الله تعالى، والاعتبار بها؛ فإننا نلاحظ، للأسف، غياب "التفكير السُّنَنِي" في حياتنا، بل والإصرار على مخالفته كأننا مأمورون باجتنابه وليس بممارسته!
وأما "التفكير السُّنَنِي" الذي نقصده في هذا المقال، فهو الانطلاق في الفهم والنظر- ومن ثم، في العمل- مما توجبه السنن الإلهية التي وضعَها الله تعالى في خَلقه أفرادًا ومجتمعات وكَوْنًا، وجَعَلها قوانينَ حاكمةً لحركة الحياة والأحياء، لا تبديل لها ولا تحويل.
وهذه السنن أو القوانين قد أشار إليها القرآن الكريم- والسنة أيضًا- في أكثر من موضع؛ في مثل قوله تعالى: {إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} (محمد: 7)، {كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ} (المجادلة: 21)، {إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا} (الكهف: 30)، {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ} (الرعد: 11)، {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} (الأنفال: 46)، {وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ} (الحج: 18)، {لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ ۗ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا} (النساء: 123)، {وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ} (يوسف: 110)، {وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم} (محمد: 38).
وحثنا القرآن الكريم على الانتباه لهذه السنن، وأمرنا بِوَضْعِها موضع الاعتبار والتنفيذ، فقال تعالى: {قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ} (آل عمران: 137)، {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا} (محمد: 10).
ومع أن الفكر الإسلامي قديمًا وحديثًا- من ابن حزم وابن خلدون إلى محمد عبده ورشيد رضا و مالك بن نبي – قد التفت إلى السنن الإلهية وأهميتها، فإن هذه الجهود لم تستطع أن تجذِّر "التفكير السُّنَنِي" في واقعنا ومجتمعاتنا، وبَدَتْ جهودًا غير متراكمة.. ربما لأن "التفكير السُّنَنِي" يأتي في قلب معادلة النهوض الحضاري المطلوبة بإلحاح؛ وما دمنا بعيدين عن تحقيق هذه المعادلة وشرائطها، فلا غرو أن تفصلنا الفواصل عن "التفكير السنني"، ونكون غارقين فيما يخالفه!
ويكفي في هذا الصدد أن نلفت إلى أن السيد رشيد رضا دعا إلى إفراد السنن الإلهية بِعِلم من العلوم، كما حصل مع العلوم التي تفرعت عن القرآن والسنة؛ فقال: "إِنَّ إِرْشَادَ اللهِ إِيَّانَا إِلَى أَنَّ لَهُ فِي خَلْقِهِ سُنَنًا، يُوجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَجْعَلَ هَذِهِ السُّنَنَ عِلْمًا مِنَ الْعُلُومِ الْمُدَوَّنَةِ؛ لِنَسْتَدِيمَ مَا فِيهَا مِنَ الْهِدَايَةِ وَالْمَوْعِظَةِ عَلَى أَكْمَلِ وَجْهٍ؛ فَيَجِبُ عَلَى الْأُمَّةِ فِي مَجْمُوعِهَا أَنْ يَكُونَ فِيهَا قَوْمٌ يُبَيِّنُونَ لَهَا سُنَنَ اللهِ فِي خَلْقِهِ كَمَا فَعَلُوا فِي غَيْرِ هَذَا الْعِلْمِ مِنَ الْعُلُومِ وَالْفُنُونِ الَّتِي أَرْشَدَ إِلَيْهَا الْقُرْآنُ بِالْإِجْمَالِ وَقَدْ بَيَّنَهَا الْعُلَمَاءُ بِالتَّفْصِيلِ عَمَلًا بِإِرْشَادِهِ، كَالتَّوْحِيدِ وَالْأُصُولِ وَالْفِقْهِ. وَالْعِلْمُ بِسُنَنِ اللهِ تَعَالَى مِنْ أَهَمِّ الْعُلُومِ وَأَنْفَعِهَا… وَلَكَ أَنْ تُسَمِّيَهُ (عِلْمَ السُّنَنِ الْإِلَهِيَّةِ) أَوْ (عِلْمَ الِاجْتِمَاعِ) أَوْ (عِلْمَ السِّيَاسَةِ الدِّينِيَّةِ)"([1]). وبيَّن رحمه الله أن "فَائِدَة هَذَا الْعِلْمِ فِي الْأُمَمِ، كَفَائِدَةِ عِلْمِ النَّحْوِ وَالْبَيَانِ فِي حِفْظِ اللُّغَةِ"([2]).
والسنن الإلهية في الاجتماع البشري تعني، كما يقول صاحب المنار: أنَّ أَمْرَ الْبَشَرِ فِي اجْتِمَاعِهِمْ، وَمَا يَعْرِضُ فِيهِ مِنْ مُصَارَعَةِ الْحَقِّ لِلْبَاطِلِ، وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنَ الْحَرْبِ وَالنِّزَالِ وَالْمُلْكِ وَالسِّيَادَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ قَدْ جَرَى عَلَى طُرُقٍ قَوِيمَةٍ وَقَوَاعِدَ ثَابِتَةٍ اقْتَضَاهَا النِّظَامُ الْعَامّ،ُ وَلَيْسَ الْأَمْرُ أُنُفًا كَمَا يَزْعُمُ الْقَدَرِيَّةُ، وَلَا تَحَكُّمًا وَاسْتِبْدَادًا كَمَا يَتَوَهَّمُ الْحَشْوِيَّةُ([3]).
وإذا أردنا مجرد إشارةٍ إلى ما يخالف "التفكير السنني"، فيمكن أن نذكر: "اللاتفكير"، أي إهمال العقل وازدراءه من الأساس.. أو "التفكير العشوائي"؛ غير المنضبط بقواعد العقل والاجتماع والعمران.. أو "التفكير العاطفي"؛ القائم على الرغبة والميل.. أو نشير إلى غير ذلك مما لا يستند على حجة واضحة، ولا يَعْتبر بسُنَّةٍ ماضية، ولا يقوم على فَهْم سليم للحقائق والوقائع، ولا يمد البصر خارج ضِيق حدود الزمان والمكان الراهنين.
وأما إجابة السؤال الذي اتخذناه عنوانًا، وهو: لماذا غاب عنا "التفكير السُّنَنِي"؟ فيمكن أن نشير إلى عدة أمور أسهمت في هذا الغياب، وأورثتنا حالة من التخبط والتراجع الحضاري.. ومنها:
عدم الاهتمام بالتاريخ
فظنَنا أنه عِلم على هامش مجالات المعرفة، بينما هو يقع في القلب منها. "فَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْقُرْآنِ تَقْرِيبًا قَصَصٌ، وَتَوْجِيهٌ لِلْأَنْظَارِ إِلَى الِاعْتِبَارِ بِأَحْوَالِ الْأُمَمِ، فِي كُفْرِهِمْ وَإِيمَانِهِمْ، وَشَقَاوَتِهِمْ وَسَعَادَتِهِمْ، وَلَا شَيْءَ يَهْدِي الْإِنْسَانَ كَالْمَثُلَاتِ وَالْوَقَائِعِ. فَإِذَا امْتَثَلْنَا الْأَمْرَ وَالْإِرْشَادَ، وَنَظَرْنَا فِي أَحْوَالِ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ، وَأَسْبَابِ عِلْمِهِمْ وَجَهْلِهِمْ، وَقُوَّتِهِمْ وَضَعْفِهِمْ، وَعِزِّهِمْ وَذُلِّهِمْ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَعْرِضُ لِلْأُمَمِ – كَانَ لِهَذَا النَّظَرِ أَثَرٌ فِي نُفُوسِنَا يَحْمِلُنَا عَلَى حُسْنِ الْأُسْوَةِ وَالِاقْتِدَاءِ بِأَخْبَارِ تِلْكَ الْأُمَمِ فِيمَا كَانَ سَبَبَ السَّعَادَةِ وَالتَّمَكُّنِ فِي الْأَرْضِ، وَاجْتِنَابِ مَا كَانَ سَبَبَ الشَّقَاوَةِ أَوِ الْهَلَاكِ وَالدَّمَارِ. وَمِنْ هُنَا يَنْجَلِي لِلْعَاقِلِ شَأْنُ عِلْمِ التَّارِيخِ وَمَا فِيهِ مِنَ الْفَوَائِدِ وَالثَّمَرَاتِ"([4]).
التعامل مع التاريخ باعتباره قصصًا لا سننًا
وتلك آفة أخر تصيب فَهْمنا للتاريخ؛ فنظنه مجرد حكايات تُروَى، وقصصًا تُتَناقل، وليس سُننًا تَهدِي، وقوانين تُستنَبط! ولهذا قرر ابن خلدون أن المستقبل شبيه بالماضي، أو أن الماضي يتكرر في المستقبل- طبعًا تَكَرُّرَ السُّننِ والعِبر، لا الأشخاص والأحداث؛ فقال: "الماضي أشبه بالآتي من الماء بالماء"([5]).
والتاريخ، كما يوضح ابن خلدون، له (ظاهر): لا يزيد على أنه أخبار عن الأيّام والدّول، والسّوابق من القرون الأول.. وله (باطن): يحتوي على نظر وتحقيق، وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيّات الوقائع وأسبابها عميق([6]). لكن يبدو أننا نستسهل الانشغال بظاهر التاريخ، عن الغوص في باطنه؛ أي سننه وقوانينه!
الفهم الخاطئ للقَدَر
فمن يفهم القدر جَبْرًا وإكراهًا- كما ألمح رشيد رضا، فيما سبق- لن يلتفت لما أودعه الله تعالى في الكون والخَلق من سنن، ولن يضع إرادة الإنسان موضعها اللائق من معادلات التغيير.. وفي هذا ظلم للإنسان من ناحية، وفهم خاطئ لسنن الله تعالى من ناحية أخرى.
فلو كان الإنسان معدوم الحيلة، ومسلوب الإرادة؛ لما كان ثمة معنىً لتكليفه بإقامة العبادة، وبعمارة الكون، وبالسير في الأرض! أما وقد وقع التكليف بهذا، فإنه يعني امتلاكَ الإنسان لحرية الفعل والترك، والالتزام والإعراض؛ لأن الدنيا دار اختبار؛ ولا اختبار مع الإكراه.. ثم الآخرة دار حساب وجزاء.
فينبغي أن نفهم القدر فهمًا صحيحًا، ونعيد الاعتبار لموضع الإرادة الإنسانية أمام التدبير الإلهي.. دون أن ينحرف بنا الفهم إلى تصور أن في الكون مَن يشذ عن قدرة الله تعالى وسلطانه.. وإنما حرية الإنسان هي مما أراده الله تعالى لخلقه في الدنيا.
الركون للراحة والدعة
"الفهم السنني" يوجب علينا العمل والجد والمثابرة، والأخذ بالأسباب وعدم التقصير فيها، وبذل الوسع واستفراغ الجهد.. هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيَّد من الله تعالى بالوحي وبالملائكة، ولو شاء الله لخرق له السنن!
لكن الله تعالى أراد من سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم أن تكون نموذجًا عمليًّا لمن سيعقبها من أجيال؛ فجاءت سيرته العطرة على وفق السنن الإلهية المبثوثة في الكون وفي الاجتماع البشري.. حتى إذا ما خولفت هذه السنن، وقعت الهزيمة، ولم يشفع للمسلمين وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم! بل كانت هزيمتهم انتصارًا للنبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ دلَّت على أن مخالفة أمره موجِبة للهزيمة.
ولهذا فمن يرغبون في الركون للراحة والدعة، لن يشغلوا أنفسهم بالسنن الإلهية وما تستوجبه من عمل حثيث، وجهد متواصل، وتخطيط محكم! بل سيخلدون للنومِ مُدَّعين توكلهم على الله، وما هم إلا متواكلون!
([1]) تفسير المنار، 4/ 114، 115.
([2]) المصدر نفسه، 8/ 96.
([3]) المصدر نفسه، 4/ 115.
([4]) المصدر نفسه، 1/ 56.
([5]) مقدمة ابن خلدون، 1/ 292.
([6]) المصدر نفسه، 1/ 282.