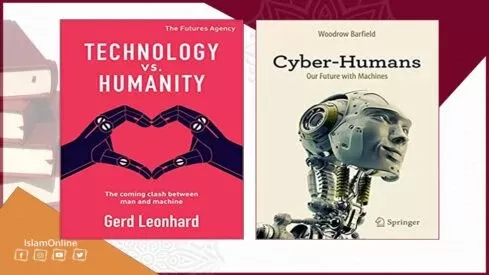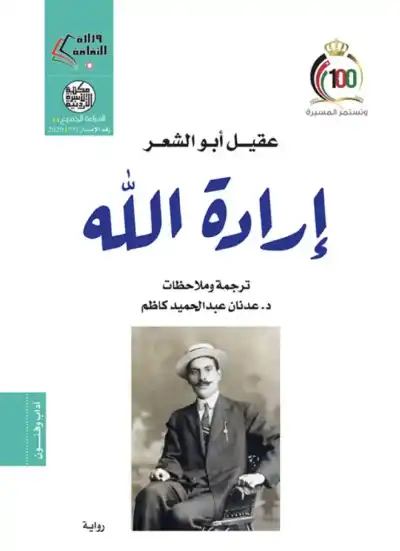مدار الساعة - "ما قادك شيء مثل الوهم" هكذا كان يقول "ابن عطاء الله السكندري"، فالوهم، والخوف، والقلق، والتوتر، والاغتراب، من تجليات غياب اليقين وغياب الطمأنينة عن الإنسان المعاصر، الذي حاصرته المخاوف، وعصفت به، حتى بات مستسلما؛ بل بات التخويف من وسائل الإخضاع والسيطرة.
في مقال بعنوان " الروايات الكلاسيكية التي تحمل موضوعات الاغتراب تحظى بتبجيل المراهقين"، يؤكد أن هؤلاء المراهقين يفضلون الروايات التي تتحدث عن اغتراب الإنسان، ويشعرون أن أبطالها يمرون بنفس تجربتهم، وهؤلاء المراهقين يقرأون لكُتاب عُرف عنهم التشاؤم والسوداوية والاغتراب مثل "ألبير كامي" و"ألدوس هسكلي"، وعلى الجانب الآخر غذت السينما الخوف، من خلال الأفلام التي تتحدث عن نهاية العالم، والتي زادت على أربعمائة فيلم، استنفذت كل خيال يمكن أن يزعزع الطمأنينة في النفس، من مخلوقات تغزو الأرض، إلى خروج مخلوقات عن السيطرة، إلى الأوبئة، والكوارث، وسيطرة الآلة على حياة الإنسان، فأصبح كل من يشاهد الفيلم يخرج وهو أكثر قلقا وتوترا، وأقل اطمئنانا.
الطمأنينة ضحيةوالواقع أن تفشي الخوف والقلق يرجع إلى أن المادية أصبحت هي المركزية المسيطرة على الإنسان، وأخذ الإنسان يتوارى، وتوارى معه الإله، ويمكن أن نقتبس هنا المعنى فيما قاله الشاعر الشهير "جوته":"كلما ازددت إحساساً بإنسانيتك، ازددت قرباً من الإله"، وفقدان الطمأنينة، ليس مقتصرا على المجتمعات الغربية، ولكنه مرتبط بالمجتمعات التي شهدت تحولات اقتصادية واجتماعية وفكرية، دون أن تواكبها حركة موازية في التدين والأخلاق، لذا نشأت كل المثالب التي أصبحت تؤرق الإنسان، وتفرض عليه أزماتها.
الطمأنينة، إحدى ضحايا تلك التطورات والتوترات، التي عاشتها المجتمعات مع عصر التنوير والنهضة الصناعية، ثم الطفرة التكنولوجية والثورة الرقمية، التي أدت إلى تآكل الأخلاقية والمعيارية، وانتشار هزات اليقين التي ضربت القلوب والأفكار، يشير الفيلسوف "يورغن هابرماس" في كتابه "العلم والتكنولوجيا كأيديولوجيا" أنه برغم الدور الذي لعبته العقلانية في المجتمعات الغربية، إلا أنه سيطرت على مجمل الحياة الاجتماعية، وأبعدت الإنسان عن ذاته، وأصابته بالاغتراب، وهي فكرة يؤكد عليها الدكتور عبد الوهاب المسيري، في كتابه "الفردوس الأرضي"، عن الانصراف الكامل لفكرة الإنتاج، والتي دهست الإنسان من داخله وأفقدت الثقة بنفس، فيقول: "وأصبحت مضاعفة الإنتاج أمرا مرغوبا فيه دون اعتبار لحاجات الإنسان الحقيقية ودون أي احترام لإمكانيات البيئة الطبيعية, أي أن هدف الإنتاج لم يعد إشباع الرغبات الإنسانية، وإنما أصبح هو ذاته الهدف والمثل الأعلى، وهذا هو قمة الاغتراب".
في كتاب "التكنولوجيا مقابل الإنسانية: الصدام القادم بين الإنسان والآلة "[1] يؤكد مؤلفه "جيرد ليونارد" Gerd Leonhard، أن عصر الآلة أكبر نقطة تحول في حياة الإنسان على الأرض، حيث وضعت التكنولوجيا مقابل الإنسانية، وسينعكس ذلك الخرائط الأخلاقية مع دخول الإنسانية إلى الذكاء الاصطناعي، ويؤكد أن الصدام اقترب بين التكنولوجيا والإنسانية، وأن الإنسان سيتغير معناه إلى الأبد حسب نتيجة الصدام، بعدما أصبحا أمام ما يمكن أن نطلق عليه "الأصولية الرقمية" the digital fundamentalism، فتسارع التكنولوجيا أصبحا مقلقا، والتكنولوجيا تتسم بأنها طبيعة غير مكتملة في مواجهة الإنسانية.
وما يؤكد هذا القلق ما جاء في كتاب "الإنسان السبراني: مستقبلنا بالآلات "[2] الذي يشير أن المتوقع أن تتجاوز الروبوتات الذكاء البشري خلال الخمسين عامًا القادمة، ومعنى ذلك أن تكون هناك احتمالات للاندماج بين الإنسان والآلة، والتساؤل هنا: كيف تستقيم العلاقة بين الإنسان وتلك الروبوتات، وكيف يجد طمأنينته، وهناك تساؤلات مطروحه في العالم الغربي بشأن عمليات التوسع في الروبوتات وأخلاقيات ذلك، من تلك التساؤلات: ماذا يحدث عندما يتم تجريد الكلمات من إنسانيتها ، وتغذيتها في آلات عديمة الإحساس؟!.
أزمة الإنسانتشير غربية أبحاث إلى وجود علاقة بين الدين والصحة العقلية، فحضور الشعائر الدينية يؤدي إلى قلة مشاعر القلق، إذ توجد علاقة إيجابية بين التدين والهدوء والطمأنينة، فالإيمان بالآخرة يحمي من الآثار السلبية لسوء الصحة والتدهور المالي، والإيمان يخلق الطمأنينة ويدعم فكرة المعنى من الحياة، لكن التكنولوجيا شيدت كهوفا ضخمة بين البشر، وقللت التواصل بينهم، وجعلت الإنسان في حاجة ماسة إلى العواطف، فرغم أن العقلانية بشرت بالطمأنية ارتكاز على قدرة العلم، والعقل على حل المشكلات وإيجاد السعادة، تحولت الطمأنينة مع الوقت إلى حلم مفقود، وغيابها كابوس قائم، لذا انتشرت فلسفة العدمية، وظهرت الدعوة للانتحار، لذا لم يكن غريبا أن تصف الفسلفة الوجودية ما يجري للإنسان بـ"الدوار" الناتج عن القلق وغياب الطمأنينة.
ولا شك أن هناك اختلافا بين القلق والخوف، فالخوف يكون سببه واضح ومن شيء بعينه، أما القلق فهو الامتلاء بالفراغ، فينشأ من منه القلق، والطمأنينة تداوي الأمرين، لأنها تخلق يقينا عميقا، وإحساسا واضحا بالمعني، تغيب معه أية مشاعر بالعدمية، وللفيلسوف الفرنسي "باسكال" كلمات تلخص تلك المشاعر المضطربة والقلق الفاقدة للبوصلة، بقول بليغ:"حين أرى العمى والبؤس لدى الإنسان، حين أشاهد كل الكون صامتاً، والإنسان متروكاً لنفسه بلا ضوء، حائراً في هذه الزاوية من الكون، من دون معرفة مَن وضعه هنا، ماذا جاء ليفعل، وماذا سيصبح، حين سيموت عاجزاً عن كل معرفة، أدخل في الذعر، مثل رجل حُمل نائماً في جزيرة قاحلة ومرعبة، واستيقظ من دون معرفة أين هو، ومن دون وسيلة للخروج".
قلق كبير تحمله العبارة، إنها تؤكد أن أزمة الإنسان مع داخله، بعدما صار فارغا، والفراغ يجذب كل مشاعر القلق والخوف وغياب الطمأنينة، فمشى الإنسان في طريق الشقاء والتوتر، وهي ظاهرة لا تقتصر على المجتمعات الغربية ولكنها ظاهرة لكل مجتمع أو فرد يعطي ظهره لحقائق الألوهية والوجود.
وربما هذا ما أبداه الفيلسوف "روبرت ماركيوز" Herbert Marcuse عندما تحدث عن قلقه من أن يتحول الإنسان إلى كيان مكون من بعد واحد[3] هو البعد المادي، ورغم أن الكتاب نشر عام 1964م، إلا أن ما طرحه من قلق لم يحصل على طمأنينة، أو إجابات شافية، وهنا يُخلق الاغتراب، وتخلق معه كل المخاوف، وتغيب كل فكرة عن الطمأنينة، ويصبح عقل "الإنسان أداتيا" أو تقنيا على حد وصفه، ويغيب الإنسان داخل الإنسان.
لكن مازال هناك إصرار في الرؤية المادية على مناقشة غياب الطمأنينة على الأرضية المادية، والنظر إليها من منظور التنمية البشرية باعتبارها مهارة يجب أن يتعلمها الإنسان، ومجموعة من السلوكيات والتطبيقات، التي إذا برع فيها الإنسان تحققت طمأنينته، متجاهلين أن السبب الرئيسي في غياب الطمأنينة هو القلق الوجودي، وغياب فكرة الإله عن الإنسان، وضياع فكرة المعنى، فمثلا كتاب "الحاجة إلى اليقين"[4] يقول يقدم إرشادات للحصول على الطمأنينة، والعودة إلى الحياة من خلال زيادة القدرة على التعامل مع عدم اليقين، ويؤكد أطباء النفس أنه "في كثير من الأحيان، يكون الضرر الذي يلحق بالجهاز المناعي، ما هو إلا استجابة للشك وغياب الطمأنينة.
[1] عنوان الكتاب Technology vs. Humanity: The coming clash between man and machine [2] Cyber-Humans: Our Future with Machines [3] راجع كتاب One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society [4] Needing to Know for Sure