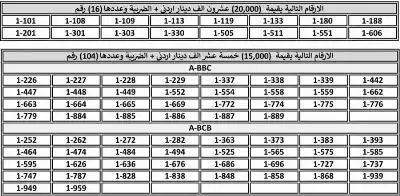هل يتحمّل الاعلام جزءا من مسؤولية هذا الفساد الذي اكتشفناه والآخر الذي لم نكتشفه؟ إذا تجاوزنا «الدور» الايجابي الذي نهضت به بعض وسائل الاعلام في السنوات الماضية في اطار «المتاح» السياسي ومناخات الحرية المسموح بها وهو دور مقدّر لا ريب، فان من الشجاعة ان نعترف بأن الاعلام يتحمل قسطا من هذه المسؤولية المهنية و الاخلاقية والوطنية ايضا، ليس فقط لان الاعلام يمثل الضمير العام للمجتمع وانما لانه ايضا الرقيب الذي يفترض ان تظل عيونه مفتوحة على حركة المجال العام والفاعلين فيه على الدوام.
أخطأ الاعلام (بدون تعميم ) هنا ثلاث مرات: مرة حين تنازل عن دوره وتجاهل مهمته الرقابية والاستقصائية فلم يتحرك لكشف الفساد والبحث عن الذين يمارسونه او يساندونه، ومرة ثانية حين صفق للفاسدين وانضم الى دواوينهم واستفاد من التغطية عليهم، وبالتالي اصبحت بعض وسائل الاعلام شريكا للفساد، ومرة ثالثة حين انحاز بالترويج لهم او بالصمت على افعالهم وتعمد في المقابل ابراز الوجه الاخر المشرق لمجتمعنا بما فيه من صور لشخصيات تحظى بالنظافة والاستقامة والنزاهة.
لكي اكون منصفا هنا لا بد ان اشير الى مسألتين: الاولى تتعلق بضرورة النظر الى السياقات السياسية العامة عند الحكم على اداء الاعلام باعتبار ان نقد الممارسات الاعلامية او تقويم الفعل الاعلامي بمعزل عن فهم ارادة الدولة في الاصلاح وحقائقه على الارض سيولّد نوعا من سوء الفهم وسوء الظن والتقدير للواجب الذي يقوم به الاعلام ودرجة انحيازه الى الضمير العام او الى نقضيه الذي –غالبا- ما يخضع لحسابات سياسية او شخصية معزولة عن حركة المجتمع ومطالبه وحاجاته.
المسألة الثانية هي انه لا يمكن للاعلام ان يتحرك في الاتجاه الصحيح، الا اذا توفرت له بيئة اجتماعية تمنحه الحركة وتمكنه من الارتقاء بخطابه الى مستوى ارادة الناس وطموحاتهم، وبهذا المعنى فان اصلاح الاعلام بمعزل عن اصلاح المجال الاجتماعي يبدو في غاية الصعوبة، كما ان تحميل الاعلام مسؤولية الخلل لوحده، دون النظر الى حالة المجتمع، وحالة الاعلام المنهك جراء ظروف ذاتية واخرى موضوعية، فيه ظلم كبير للاعلام وللاعلاميين معا.
في المقابل لم يعد ثمة شيء يمكن التغطية عليه او اخفاؤه أو التوهم بأنه ما زال بعيداً عن «آذان» الناس التي فتحت من جديد لتستقبل كل ما يصلها من ذبذبات، خاصة بعد ان اصبح الفضاء الافتراضي في عصر الشبكات متاحا للجميع، واصبحت مصادر المعلومات متوفرة، وتحول المواطن الى صحفي، لكن أخطر ما يمكن ان يحدث في مرحلة الانكشاف هذه هو ان نصدق (نحن الجمهور) كل ما يأتينا من اخبار او ان نتعامل معها بعقول مغلقة، او ان يتعامل معها المسؤولون في الاعلام بمنطق «لا نرى «، أو» لا نريد ان نصدق»، اولا نملك ما يلزم من الارادة والجرأة على الاعتراف بالخطأ، ومواجهته بحلول حقيقية تقنع الناس وتطمئنهم على الحقيقة.
اعرف ان وقوف الاعلام في خندق مواجهة الفساد ليس مجرد امنية تتحقق بكبسة «زر»، كما اعرف ان المعركة مع رؤوس الفساد ليست سهلة وان الطريق الى المحاكم والسجون ليست معبدة بالنوايا ومحاولات التنفيس فقط، ولكن استعادة ثقة الناس بالدولة وبالنظام والقانون تستدعي ان نخرج جميعا ( وفي مقدمتنا الاعلام) من دائرة الخوف والتردد ومن حسابات المجاملة والتصفيق واعتبارات القلق غير الصحيح، فلم يعد بمقدور احد ان يستهين بذكاء الناس ولا بوعيهم ومعرفتهم بتفاصيل المشهد العام وما جرى فيه من عبث وفساد، ولم يعد من مصلحة الدولة واعلامها الرسمي والاخر المستقل نسبيا ان تغامر بوجودها وعافيتها لارضاء اي طرف او الخضوع لرغباته ذلك ان فتح ملفات الفساد لا تختلف عن فتح الجسد المريض لاجراء ما يلزم من عمليات له، وأي تلكؤ او تأخير او سوء تقدير في ذلك سيذهب بنا الى المجهول.. وسيولّد مزيدا من الازمات والاحتقانات التي لا نعرف الى أين ستأخذنا ولا الثمن الذي سندفعه جراء غفلتنا عنها او تجاهلنا لآثارها الخطيرة.
باختصار، لكي يخرج الاعلام بريئا من تهمة الصمت او التواطئ او التقصير في «معركة» مواجهة الفساد وكشف طوابق الفاسدين، سواء اكانوا من النواطير او من الهوامير، لا بد ان يقدم شهادته للجمهور، وهي شهادة ضرورية لكي ينال ثقتهم او لكي يتجنب عزوفهم عنه.
الدستور