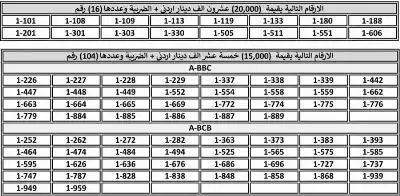استشعر جلالة الملك مؤخراً أهمية الاستقرار، خاصة الزمني، لتمكين المؤسسات السياسية من القيام بوظائفها المتنوعة؛ حيث أكد أكثر من مرة على ضرورة ان يتم البرلمان مدته الدستورية، المتمثلة بأربع سنوات، رابطاً ذلك بديمومة الرضى المجتمعي عن أداءه، كما وضع جلالته السلطة التنفيذية في حالة زمنية مماثلة – أربع سنوات- معلقاً حياتها بقناعة البرلمان بأداء تلك السلطة؛ مُنشأً علاقة متكاملة بين المواطنين والبرلمان والحكومة باعتبار خيطها الناظم مُستمد من القناعة بنوعية الأداء للجميع . كل ذلك ساهم في زيادة قدرة تلك المؤسسات على الإنجاز التشريعي والخدمي؛ نظراً لكفاية الوقت الذي يصنع منها مؤسسات مؤهلة للتعامل مع القضايا المستجدة في إطار من التخطيط والتنبؤ.
فبعد التحول الذي لف مفهوم الامن الوطني، وطوره من مفهوم تكتيكي الى مفهوم استراتيجي، مستنبتاً اطرافاً واذرعاً جديدة رديفة لذراعه الأساسية، وأصبح بذلك مفهوماً شاملاً؛ مغادراً بذلك أفقه القديم الضيق، باعتباره منوطاً ببعده العسكري فقط إلى رحاب منظومة الامن الشاملة؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعرفية، متكئاً على التخطيط الاستراتيجي، ووضع السيناريوهات و"استمطار" المستقبل، فقد اصبح من الضرورة بمكان اتاحة الوقت الكافي لرؤوس الأجهزة الأمنية ليثبتوا مدى براعتهم الأمنية ضمن سياق زمني مساو لنظرائهم السياسيين بعيداً عن " كهربة" اجوائهم بفولتية عالية مليئة بتيارات الاشاعة التي تخلق حالة من اللا عمل و اللا سكون لا تخدم سوى مثيريها وكارهي الاستقرار والانجاز لهذا البلد.
وهنا نتساءل لماذا تعتمد اغلب الدول مدة الأربع سنوات لرؤسائها، او لبرلماناتها، أو لقياديها التنفيذيين؟ من الممكن تفسير ذلك؛ باعتبارها مدة كافية للحكم على الأشخاص بمقدرتهم على الأداء المميز من عدمه؛ من خلال ظهور نتائج يمكن فحصها، كما انها تأتي بين الخطط الثلاثية والخمسية من حيث ضمان تنفيذ الثلاثية وإدخال ما تحتاجه الخماسية من تعديلات بناءً على المستجدات الواقعة او المتوقعة. أضف لذلك أن معظم المشاريع ذات الطبيعة السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية أو الأمنية - خاصة إذا كانت تختلف شيئاً ما عن الطبيعة التكوينية للمجتمع برمته - تحتاج وقتاً ليس باليسير؛ لتبني منشآت، أو تغير قناعات، قد تبدو للوهلة الأولى مغلفة بشيء من الحداثة، او تغيير النهج الذي اتفق الجميع على ضرورة تغييره. ويمكن اعتبارها ايضاً فترة كافية لكي يعد المنافسون أنفسهم لتولي زمام المواقع القيادية؛ محاولين تجنب أخطاء اسلافهم بعد رصدها ودراسة ردود الأفعال المختلفة تجاهها أو حتى رؤيتهم ومنهجهم لكيفية وجوب تحوير عملها مستقبلاً.
وإذا كانت الأخطاء هي المسبب الرئيس وراء اجراء التغيير، فلا بد لنا هنا من تصنيف الأخطاء وفقاً لمحورين مختلفين، بمستويين متباينين لكل منها، فالمحور الافقي يجمع بين مستويات الاخطاء الفردية والذي ينم عن سوء تقدير، أو تبعاً لطبيعة فسيولوجية للفرد لم تروض بالرغم من كل ما مورس عليها من تأهيل بدني وعقلي، فيما المستوى الثاني من هذا المحور جماعياً بمعنى أنه منهجي او مؤسسي، وهذه غير وارد في سياقات اجهزتنا الأمنية. فيما يجمع المحور العمودي بين مستويين للأخطاء ضمن التسلسل القيادي للجهاز الأمني، بمعنى معرفة مصدر الخطأ هل هو ناتج عن توجيه مباشر من قائد الجهاز أم أنه صدر من مستويات قيادية أقل؟ في خضم كل ذلك، لا بد من التنبه إلى مُسلمة مهمة مفادها انه " كلما اتسعت القاعدة الجماهيرية زادت نسبة الخطأ" أي ان العلاقة طردية بين العدد والخطأ فبالنظر إلى حجم الموارد البشرية التي تأتلف منها تلك المجاميع الأمنية تجعل من احتمالية الخطأ واردة، فضلاً عن ان الفعل الذي يمكن أن يعتبره البعض خطأ ليس بالضرورة أن يكون كذلك من وجهة نظر أمنية.
ولا يمكن اغفال الناحية الاقتصادية المترتبة على اجراء التغييرات ضمن سياق زمني قصير، كل هذا لا يعفي القادة الأمنيين من نظرية أنه يمثل الجهاز برمته، وان أي تصرف سواء كان فردياً او جماعياً يندرج فعلياً تحت نطاقه؛ فاستحداث مراكز بحثية استراتيجية داخل كل جهاز، بالتركيز على خصوصيته ليتم رفد المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات وغيره من المراكز ذات الصلة امر غاية في الأهمية، والزيارات المفاجئة للمديريات قد تأتي اكلها وترفع من سوية التأهب الدائم، ورفع مستوى الافراد والضباط سواءً من الناحية البدنية أو التوعوية وتكثيف الدورات الاجتماعية، وإبراز دور الايمان ليغدوا موجهاً وطنياً، من شأنها ان تساهم في ضبط بعض السلوكيات غير المنتظمة هنا او هناك.
adel.hawatmeh@gju.edu.jo