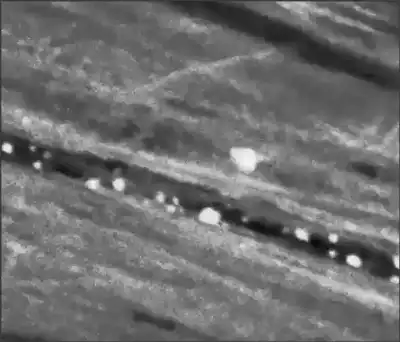إبراهيم السواعير
يتبيّن وقع خطواته، وهو يحمل أحزانه الصحراويّة، إلى حيث أبجديات الدرس الأولى: بين يدي (خطيب) وأوابد سُود يتخذونها مقاعد للدرس كانت تتهجّأ مع جيلهِ في خمسينيات القرن الماضي، في (أمّ الجمال) شمال المفرق، شيئاً من قرآن وتحفظ طائفةً من أشعار وتتمرّن على بعض عملياتٍ يسيرةٍ من حساب.
كانت تلك مادّة الطفل الموهبة في البادية التي اهتزّ وجدانها عام تسعةٍ وأربعين من القرن الماضي لميلاد (عواد سليم عقلة الرحيبة المساعيد)؛ الطفل الشاهد على عذابات أهله الذين استساغوا باديتهم عذوبةً، وأودعوا في فضائها أبناءهم ليعمروا جنباتها، على ما في الجنبات من شوكٍ ومراراتٍ ودموع.
أشجانٌ تنزّ لها الدمعة، في استذكاره الصفوف الأولى في الزرقاء والمفرق، وغربته المفروضة، ورغبته المقيّدة بظروفٍ كان الحلم فيها مباحاً مع أنّه صعبٌ، فكان عوّاد المساعيد يجتاز الكثير ويحترف الاعتماد على الذّات، ليقطع مسافاتٍ شائكةً غير معبّدة إلا بالصبر والجدّ والأمل.
وعلى بصيص فانوسٍ تعبث به الريح في بيت شَعر بين أمّ الجمال و(عمرة وعميرة)، كانت كليّة الشهيد فيصل، على حضورها الكبير آنذاك، موئلاً للمساعيد ولكلّ من هو في مثل همّته العالية التي أغرت الفتى بدراسة الطبّ، رغم جداله الحييّ مع آمر الكليّة الراحل الأديب اللواء عبد المجيد مهدي النسعة، صاحب النشيد الشهير (قسماً بمن رفع السماء بغير ما عمدٍ تراه.. إني سأخلص للمليك وللبلاد مدى الحياة)..
وبين تخصص الرياضيات والأحياء، كانت علامات المساعيد كلّها من فئة (الممتاز) عام ثمانية وستين، لكنّ الحياة ليست كلّها (قمرا وربيع)، ولذلك، فقد كان الاحتكام للقدر والنصيب حكمةً لدى الأردنيين في الرضا بما هو أمامهم من فرص شحيحة وتقادير قاسية يصنعون منها أجمل حياةٍ ويرسمون فيها أبواباً ونوافذ، يفرحون بها، حتى وإن كانت لا تطلّ على أحد؛ حياة عسكريّة أشبه بسيرة توهّج فيها قلبّ المساعيد ومُحيّاه في ما كان يستجدّ من أيام.
(الآخرون لهم أبٌ واحدٌ، ونحن لنا أبوان اثنان)، يقول أحد إخوته في وصف طيبة المساعيد وحنوّه وقربه منهم ومن والدهم وعلاقته الحميمة التي امتدت لكلّ الناس ورفاق السلاح فيما بعد، ومن شاركوه الغرفة الصفيّة في زمنٍ لم يكن يلتفت فيه إلى التحصيل العلميّ أحد.
وهكذا، فقد مضت الأربعون عاماً كأفضل ما تكون العسكريّة والطيبة والنخوة والحكمة في اتخاذ القرار والسرعة في تلبية الواجب والنداء.
كانت (الأربعون) تشتمل على الكثير من المرونة والحكمة والصلابة، فقد كان الامتحان الأوّل عام سبعين للمساعيد الضابط في سلاح المدفعيّة الملكي، المشارك في حرب الاستنزاف بين الأردن وإسرائيل وأحداث الأمن الداخلي الصعبة،... ليتدرّج في العديد من المناصب، قائداً للحرس الملكي ومرافقاً لجلالة المغفور له الحسين بن طلال، فقائداً للشرطة العسكرية الملكية، ومساعداً للمفتش العام، وآمراً لكليّة القيادة والأركان، وقائداً للمنطقة العسكرية الجنوبيّة، ومساعداً لرئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، ثم مديراً عاماً للدفاع المدني، وهي خبراتٌ عسكريّة مهمّة تكللت بالإرادة الملكية السامية بتعيينه عضواً في مجلس الأعيان.
وفي هذه المسافة الطويلة في خدمة الوطن والمليك، كانت مشاعر تتدفّق في كلّ محطّةٍ مضيئةٍ أو قصّةٍ يرويها «أبو سلطان» في ما اقتبسه من الحسين وعميد آل البيت جلالة الملك عبدالله الثاني، في تفاصيل رائعة تدلّ على عظمة الهاشميين وتواضعهم وحضورهم الإنساني الكبير.
الراي