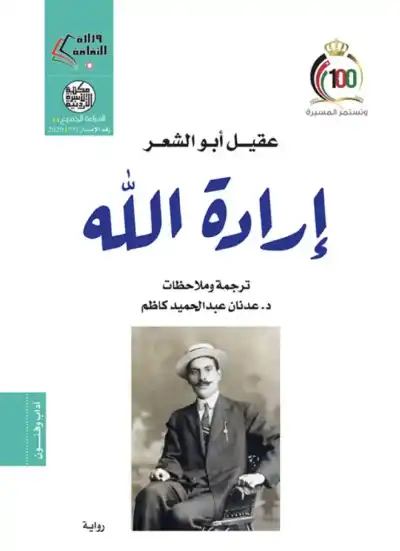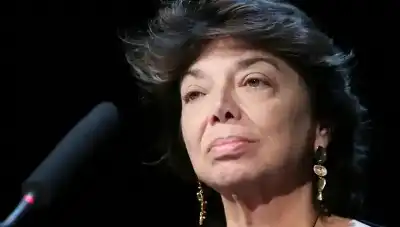مدار الساعة - ليس بإنسان ولا عاقل … من لا يعي التاريخ في صدره
ومن روى أخبار من قد مضى … أضاف أعماراً إلى عمره
لا يستفيد من التاريخ من لا يقدر أهميته, ومن لا يضعه في الموضع الذي يستحقه في قائمة العلوم المفيدة, فإن دراسة التاريخ تربطنا بمقومات الأمة من الدين واللغة والأخلاق فإذا لم تحفظ هذه الأشياء تكون الأمة عرضة للتأثير والتغيير, يقول الشيخ رشيد رضا معاتباً المسلم الذي لا يعطي التاريخ حقه من الاهتمام: "فمالك لا تعد من هذا الدين معرفة تواريخ الأمم الغابرة واختبار أحوال الأمم الحاضرة, ومعرفة الأقطار والبقاع, والعلم بشؤون الاجتماع, أليس هذا من إقامة القرآن واستعمال الفرقان والميزان"[1] وقد سبقه إلى التنويه بشأن التاريخ العلامة ابن خلدون عندما أشار إلى أن التاريخ ليس حكايات تساق للتسلية والترفيه كما يتوهم بعض الناس ببادي الرأي, يقول :"إذ هو في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول, وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات(الحوادث) ومباديها دقيق, وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق.."[2] وهناك نجد أن ابن خلدون أصاب المحز ووضع التاريخ في موضعه الصحيح, فهو ليس من العلوم الثانوية كما ذكر أبو حامد الغزالي وتبعه على ذلك الإمام النووي, يقول الأستاذ محمد كردعلي: "وما عهدنا عاقلاً يدعو أمة إلى تناسي تاريخها, بل رأينا كل أمة تدرس تاريخها مهما كان اسوداد صفحاته لأنه مهمازها إلى العمل"[3].
لقد عمق القرآن الكريم الإحساس التاريخي عند المسلمين عندما وصلهم بالأنبياء والأمم السابقة, وجعل تاريخ الخليقة مجالاً لنظرهم ومجالاً للتدبر والتفكر, قال تعالى :"ملة أبيكم ابراهيم", وقد استغل بعلم التاريخ علماء من أمثال الطبري وابن اسحاق وابن سعد وابن كثير, وقيل عن الشافعي (كان عالماً بأيام الناس) وكان الصحابة على علم بتاريخ وجغرافية البلدان المجاورة للجزيرة العربية, وهذا مما ساعدهم على التخطيط للفتوحات الكبرى, فالتاريخ قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هو تاريخ الأنبياء وبعد بعثته صار تاريخ العلماء بشتى أصناف العلوم, فالأمة الإسلامية ارتفعت بفكرها إلى أن جعلت أقوال العلماء وأفعالهم هي الجديرة بالتسجيل, وهذا اتجاه أصيل في الإسلام لم يسبق إليه, فظهرت كتب الطبقات: طبقات الصحابة والتابعين, وطبقات الفقهاء والمحدثين, وقد أدى ذلك إلى ظهور طبقات الأطباء والمؤرخين والشعراء والأدباء … الخ , فالتاريخ الحضاري عندنا متفوق على التاريخ السياسي, وبسبب العناية به عناية كبيرة بدءاً من السيرة النبوية التي ضبطت وقائعها بالرواية الصحيحة وانتهاء بالتأريخ لكل مفاصل الحياة الاجتماعية والسياسية ظهر مئات بل ألوف المؤرخين[4], وظهر ما يزيد على عشرة آلاف كتاب في التاريخ, ولم تعن أمة بتاريخ رجالها كالأمة الإسلامية, فإذا ألف أحد العلماء كتاب في الطبقات أو التاريخ العام يأتي آخر ويكمله حتى عصره فيما سمي (بالتذييل) فكتاب (جذوة المقتبس في تاريخ الأندلس) للحميدي ذيل بكتاب (بغية الملتمس) ثم (الصلة) لابن بشكوال ثم (التكملة) لابن الأبّار.
بينما نرى أن التاريخ كعلم لم يعترف به في أوروبا إلا في أواسط القرن الثامن عشر وأول كرسي للتاريخ في جامعة أوكسفورد كان في أواسط القرن الثامن عشر. وما ضعف الاهتمام به عند المسلمين إلا في العصور المتأخرة حين ابتعدت الأمة عن القيادة والريادة, وقد علل المؤرخ (علي مبارك) ضعف الأمة الإسلامية بالنقص الملحوظ في وعيهم بالتاريخ, "والأمم التي لا تقرأ تاريخها معرضة لإعادة انتاجه لغير صالحها"[5].
يقول الشيخ رشيد رضا :"فالتاريخ هو المرشد الأكبر للأمم العزيزة اليوم إلى ماهي فيه من سعة العمران, وكان القرآن هو المرشد الأول للمسلمين إلى العناية بالتاريخ ومعرفة سنن الله في الأمم, وكان الاعتقاد بوجوب حفظ السنة وسيرة السلف هو المرشد الثاني إلى ذلك"[6].
إن ديناً لا يزال يتلى في كتابه أخبار عاد وثمود وقوم شعيب ولوط وأصحاب العجل ليَقضي على المتمسكين به أن يهتموا بالتاريخ ويعتبروه من العلوم التي لا يصح إهمالها, ولا يكره الكتابة عن تاريخ العظماء كعمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعن تاريخ الأوطان إلا أصحاب المذاهب الهدامة.
العاقل هو الذي يتجلى له شأن التاريخ وما فيه من الفوائد والثمرات, وستأخذه الدهشة حين يرى أن كثيراً من الذين يتصدون لتعليم الناس يجهلون ماضي هذه الأمة وحاضرها مع أنهم من أكثر الناس حاجة إلى التاريخ, ليعلموا مكامن الفساد في العقائد والأخلاق والعادات التي تسربت إلى هذه الأمة وأضعفتها في دينها ودنياها, ومن الملاحظ أنه في العصر الحديث وفي زمن الاستعمار الأوربي للبلاد العربية والإسلامية, كان التاريخ واحداً من أهم مجالات الصراع, وذلك حين راح الغرب عن طريق كثير من المستشرقين يشوه التاريخ الإسلامي فقد ركزوا على الفرق المنحرفة وضخموا من دورها, فالمستشرق ماسنيون يهتم بالحلاج والسهرورد المقتول أي أئمة الإلحاد, ونرى المستشرق (جولدزيهر) يعتبر أن خطبة الرسول صلى الله عيه وسلم في حجة الوداع موضوعة, وضعها المسلمون ليذكروا المساواة بين العرب والعجم, والمستشرق (مور) يذكر أن الإسلام نزل للعرب فقط, وتحريفاتهم وتخليطهم كثير وليست هذه المقدمة هي المجال لسردها.
كان رد الفعل عند بعض الدارسين المسلمين هو التجميد المطلق لهذا التاريخ دون دراسته دراسة واعية, ودون البحث عن أسباب الحوادث وأسباب الانتصارات وأسباب التراجع.
إن رجال التربية والحكماء من الأمم الأخرى يعدون التاريخ من أهم الوسائل لاستنارة الشعوب وأنه أكبر مربٍ للأمم والأفراد, وقد روي عن الحكيم الصيني(كونفوشيوس) قوله: "لقد حاولت أن أربي الخلق عن طريقة التعليم, فعلمت تلاميذي التاريخ كي يُلهموا بالعظيم من أعمال الإنسان, وكي يجدوا في دراسة طبيعة البشر ما يكبح جماحهم", ويقول المؤرخ (كولنجود): "إن دراسة الواقع التاريخي ربما أعطت الإنسان نوعاً من الحكمة الواقعية تمكنه من العثور على طريق قويم"[7] ويقول (هرنشو): "التاريخ مدرسة لتعليم طريقة البحث السياسي إذ من الصحيح نسبياً أن التاريخ سياسة الماضي والسياسة تاريخ الحاضر, والتاريخ مدرسة تعلمنا الحذر واستقلال الرأي وسجاحة الطبع, إنها تهيء لنا ملكة الاستدلال بالأفعال الظاهرة على البواعث والأفكار الباطنة"[8].
ويقول الشيخ البشير الإبراهيمي: "إن القرآن عندما يقص علينا قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام فذلك ليشعرنا أن لنا في بناء الحق وهدم الباطل ونشر الهداية والخير أصلاً عريقاً ونسباً طويلا عريضاً , ومتى شعر الإنسان الصحيح الفطرة بزكاء الأصل تحركت فيه نوازع النخوة , وهذا هو سر سلوك المربين للأمم في إشرابها تاريخها.."[9].
ويعتبر القائد العسكري(نابليون) أن التاريخ هو الفلسفة الحقيقة وهو علم النفس الحقيقي[10] ويقول المؤرخ (كروتشي): "وعلى الفيلسوف الذي يكتب التاريخ أن يكرس نفسه للكشف عن الأسباب والنتائج والارتباط في حوادث التاريخ"[11] وبسبب هذه الغفلة عن أهمية التاريخ كتب الإمام السخاوي في كتابه(الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ) أوضح فيه فضل هذا العلم وفوائده ومن العلماء شارك فيه تحقيقاً وتعليقاً.
[1] مجلة المنار م 10/7
[2] المقدمة 1/282[3] الحاضرة العربية 1/45[4] أحصى الأستاذ شاكر مصطفى عدد المؤرخين الذين ظهروا في التاريخ الإسلامي فاجتمع له أسماء خمسة آلاف مؤرخ.
[5] محمد جابر الأنصاري: العرب والسياسة: القدس العربي 11/3/98 والكلام لجورج سانتيانا[6] تفسير المنار 1/311[7] حسين مؤنس : التاريخ والمؤرخون /167[8] فتحي عثمان: مدخل إلى التاريخ الإسلامي /50[9] الأثار الكاملة 1/394[10] ول ديورانت: قصة الفلسفة /579[11] المصدر السابق /579المصدر : alabdah.com