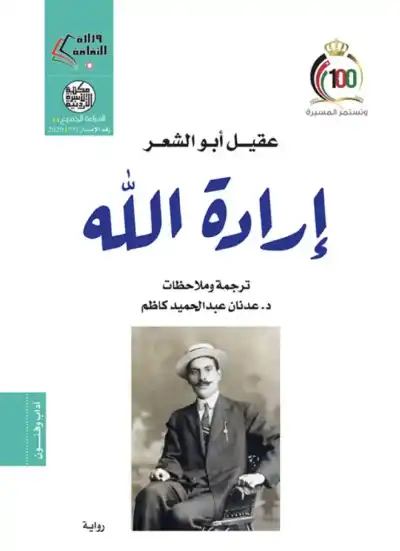مدار الساعة - إذا تأملنا مسيرة الأفكار التي يراها الناس نوعًا من الشطط والانحراف؛ فسنخلص إلى نتيجة عجيبة؛ تتمثل في أن هذه الأفكار- في أصلها، أو في دوافعها- كان لها حظٌّ من الاستقامة غير ما انتهت إليه من انحراف، ونصيبٌ من الصحة غير ما أصابها من بطلان..!
ولهذا يأتي السؤال: لماذا تنحرف الأفكار عن مسارها الصحيح، وتخرج عن القضبان؟!
وقبل أن نحاول تلمس إجابة هذا السؤال، نشير إلى اثنتين من هذه الأفكار التي انحرفت، أو بالأدق: انحرف بها أتباعها.
أولاً: الزهدالإنسان مكون من روح وجسد، ومطالَب بأن يلبي حاجات هذين الأمرين معًا بتوازن واعتدال: {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} (القصص: 77).
لكن الإنسان إذا ترك نفسه لمطالب الجسد، فإنه لا ينفك عن الدوران في حلقة مفرغة من الحاجات والمطالب التي تستدعي عملاً متواصلاً بالليل والنهار لا مكان فيه للروح! ولهذا، تأتي أهمية الدعوة إلى التخفيف من هذا السعار المادي، ومن الغلو في مطالب الجسد، مع الاعتراف بأنها مطالب ضرورية وملحة متى كانت في الحد المقبول الذي لا طغيان فيه ولا إسراف.
ثم تطورت- أو انحرفت- هذه الدعوة للموازنة بين حاجات الروح ومتطلبات الجسد إلى شيء من الزهد؛ أي الابتعاد عن حظ الجسد والجوارح، والتقليل من متاع الدنيا.. ثم كانت المبالغة في هذا الأمر حتى رأينا أفكارًا وممارسات تحتقر الجسد، وتعتبر التجاوب مع حاجاته رجسًا من عمل الشيطان! وكان بعضهم يفاخر بأن الماء لم يمس جسده من سنوات عديدة!
إن طريق العبادة لا يمكن أن يمر بحرمان الجسد من حقوقه، وإنما بتهذيب حاجاته وغرائزه.. والانحرافُ يمنة أو يسرة يُبعد الإنسان عن الوسط والاعتدال؛ الذي هو خصيصة كبرى من خصائص الإسلام.. وحديث النبي صلى الله صليه وسلم: "لكنِّي أصومُ وأفطرُ، وأصلي وأرْقدُ، وأتزوَّجُ النساءَ؛ فمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتي فليس مِنِّي" (متفق عليه)، يمثل دستورًا للمسلم في موقفه مما أحل الله من طيبات، وفي الجمع بين حاجات الروح والجسد، لا إفراط ولا تفريط..
ثانيًا: العقلانيةحينما خلق الله تعالى الإنسان وكلفه بالعبادة، لم يتركه بلا منهج؛ وإنما أرسل إليه الرسل، وأنزل معهم الكتب، وشرع لعباده الشرائع والأحكام؛ حتى يكونوا على بينة مما خُلقوا له، ومما هو مطلوب منهم: {قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} (البقرة: 38).
لكن هذا المنهج يحتاج إلى عقل يتعامل معه؛ إذ من طبيعة النصوص ألا تكون مستوعبة للحياة بكل جزئياتها؛ وإنما مهمتها بالأساس أن تضع المعالم والأصول والكليات، وألا تفصِّل إلا فيما شأنه الثبات وعدم التغير، مما هو قليل المساحة في حياة الناس القائمة على التغير والتبدل..
إذن، الإنسان بحاجة للنقل والعقل معًا، أو للنص والاجتهاد.. ومتى جمد الإنسان على النص، كان التعسير والمشقة والجمود، كما حدث من تعامل الكنيسة مع "الكتاب المقدس" في عصورها الوسطى.. مما أوجد الحاجة للخروج من هذا الجمود، وجعل من المبرر إعطاء مساحة أكبر للعقل.. وإذا كانت النصوص في الأزمنة العادية، لا تستغني عن عمل العقل، أي الاجتهاد؛ فإن الأزمات التي تنشأ عن الجمود على النص الديني، تكون فيها الحاجة أشد إلى إعمال العقل..
ثم نشأت اتجاهات تتجاوز الدعوة لتكامل العقل والنقل، إلى إعلاء العقل حتى فيما لا يقع تحت سلطانه، أي الغيبيات.
وبدلاً من أن نكون بإزاء موقف يحترم العقل ويدعو لتفعيله بنوعٍ من التكامل مع النقل، أي النص الديني؛ أصبحنا أمام أصوات متجاوزة للنقل، ومنفلتة من أية ثوابت، باسم "العقلانية"! وكأن العقل يستطيع أن يدرك المحسوسات من الأشياء وغير المحسوسات، أي الماديات والغيبيات!
إذن، رأينا أن هذه الأفكار- الزهد في مقابل الانغماس في ملذات الجسد، وتفعيل العقل في مقابل الجمود على النص- التي تكاد تكون محل اتفاق، قد انحرفت عن المسار، وتطرفت في اتجاه عكس ما جاءت لتصلح منه.. وصرنا بإزاء "تطرف جديد" بمقابل "التطرف القديم"!
وهنا، نأتي لإجابة السؤال الذي طرحناه في أول المقال، وهو: لماذا تنحرف الأفكار عن مسارها الصحيح؟! ونقول: إن وراء هذه الانحراف أسباب كثيرة بلا شك، لكن نستطيع أن نركز على ثلاثة من أهمها، وهي:
افتقاد الميزان والمعيارمن الطبيعي أن يختلف الناس، وأن تتغير الأفكار؛ فالتغير يكاد يكون صفة لازمة للحياة والأحياء؛ مثل "دورة النبات" في النمو من البذرة حتى الحصاد، و"دورة الإنسان" في الدنيا بين الميلاد والوفاة.. ولهذا، فما لم يمتلك الإنسان مع هذا التغير ميزانًا يَزِنُ به الأفكار والأعمال، فإنه يصاب بالانحراف يمنة أو يسرة!
و"الميزان" هو هدى الله، والعدل الذي تستقيم به الأمور، أو العقل الصحيح البعيد عن الأهواء. قال تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} (الحديد: 25). جاء في تفسير ابن كثير: "يَقُولُ تَعَالَى: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ) أَيْ: بِالْمُعْجِزَاتِ، وَالْحُجَجِ الْبَاهِرَاتِ، وَالدَّلَائِلِ الْقَاطِعَاتِ، (وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ) وَهُوَ: النَّقْلُ الْمُصَدِّقُ (وَالْمِيزَانَ) وَهُوَ: الْعَدْلُ. قَالَهُ مُجَاهِدٌ وقَتَادَةُ وَغَيْرُهُمَا. وَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي تَشْهَدُ بِهِ الْعُقُولُ الصَّحِيحَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ الْمُخَالِفَةُ لِلْآرَاءِ السَّقِيمَةِ"([1]).
إذن، "الميزان" منه "ميزان نقلي" قائم على الوحي وهداية السماء؛ و"ميزان عقلي" قائم على الفهم الصحيح المشترك بين الناس.. ويضاف إليهما: "ميزان الفطرة"؛ التي أودعها الله في الإنسان، وفَطَرَ الناسَ عليها.
فالميزان هو مزيحٌ من هداية الوحي واستقامة العقل وسلامة الفطرة، وهو يضبط حركة الإنسان من الانحراف، ويعينه على سلوك الطريق القويم؛ سواء في الفكر والتصور، أو العمل والسلوك ..
وكلما ابتعد الإنسان عن هذا "الميزان"، تخبط في حركته، وانحرف في مسيرته، وتنكب عن الصراط السوي!
الخروج عن حد الاعتدالإذا كان الإنسان متصفًا بمجموعة من الأخلاق والأحوال، فإن لزوم الطريق الصحيح فيها- بعيدًا عن الانحراف- يقتضي الاعتدال في هذه الصفات والأحوال؛ لأن كل واحدة منها لها حد وسط عدل يمكن الانحراف عنه يمينًا أو يسارًا.. ولهذا، كانت "الوسطية" صفة جامعة من صفات الإسلام الكلية الأساسية: { وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (البقرة: 143).
فالإقدام مثلاً إذا زاد عن حده الوسط كان تهورًا، وإذا نقص كان جبنًا.. والإعطاء إن زاد كان تبذيرًا، وإن قلَّ كان بخلاً.. ولأبي حامد الغزالي كلام مفصَّل في "الإحياء" عن ذلك، ومما جاء فيه: "أمهات الأخلاق وأصولها أربعة: الحكمة، والشجاعة، والعفة، والعدل. ونعني بالحكمة حالة للنفس بها يدرك الصواب من الخطأ في جميع الأفعال الاختيارية؛ ونعني بالعدل حالة للنفس وقوة بها تسوس الغضب والشهوة وتحملهما على مقتضى الحكمة وتضبطهما في الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاها؛ ونعني بالشجاعة كون قوة الغضب منقادة للعقل في إقدامها وإحجامها، ونعني بالعفة تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشرع؛ فمن اعتدال هذه الأصول الأربعة تصدر الأخلاق الجميلة كلها".
ثم بيَّن حال "قوة العقل" عند الاعتدال وعدمه، وما يَصدر عن ذلك، فقال: "من اعتدال قوة العقل يحصل حسنُ التدبير، وجودة الذهن، وثقابة الرأي، وإصابة الظن، والتفطن لدقائق الأعمال وخفايا آفات النفوس. ومن إفراطها تصدر المكر والخداع والدهاء. ومن تفريطها يصدر البله والغمارة والحمق والجنون".
وأوضح الغزالي أنه "لم يبلغ كمالَ الاعتدال في هذه الأربع [الحكمة، والشجاعة، والعفة، والعدل] إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس بعده متفاوتون في القرب والبعد منه؛ فكل من قرب منه في هذه الأخلاق فهو قريب من الله تعالى بقدر قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم"([2]).
فالخروج على حد الاعتدال في الأخلاق والفضائل، موجب لانحراف الفعل.. ومثل ذلك يقال في الفكر والتصور.
الاستجابة لضغط الواقعالإنسان لا يتحرك في فراغ من الأفكار والأماني والإرادات، وإنما تتصارع هذه الأمور- أو: تتدافع- مع واقع يحيط بها، ويريد أن يجذبها إلى هذه الناحية أو تلك. وتتوقف مسيرة الإنسان من حيث الاستقامة أو الانحراف على تعاطيه مع واقعه وما فيه من ضغوط وإغراءات.
فحتى الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليهم، لم يَسْلموا من التعرض لإغراءات الواقع التي كانت تهدف لِحَرْفِهم عن جادة الطريق؛ لكن الله تعالى عصمهم وحفظهم. قال تعالى: {وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا (73) وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (74) إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (75)} (من سورة الإسراء).
قال ابن عباس: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْصُومًا؛ وَلَكِنْ هَذَا تَعْرِيفٌ لِلْأُمَّةِ لِئَلَّا يَرْكَنَ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَشَرَائِعِهِ"([3]).
فالواقع له دور كبير في إحداث تغيير في الأفكار؛ وقد يكون هذا التغيير محمودًا إذا كان يرمي إلى تفعيل الفكرة وجَعْلِها واقعًا ملموسًا، مع الإضافة إليها بما يمكِّن لها.. وقد يكون مذمومًا إذا كان الهدف منه محو الفكرة أو تشويهها.
وما لم ينتبه صاحب الفكرة لكيفية التعاطي الصحيح مع الواقع- والواقع لا يمكن الفكاك منه؛ لأن الإنسان لا يتحرك في فراغ كما أشرنا- فما أيسر أن تصاب فكرته بما يشوهها، سواء بالزيادة عليها بما يناقضها، أو بالانتقاص منها بما يبطلها!
إذن، هذه ثلاثة أسباب أساسية تحرف الأفكار عن مسارها، إفراطًا أو تفريطًا؛ بما يُشوِّه الفكرة، ويُخرِجها عن الهدف الذي جُعلت له، والغاية التي تَنشدها.
([1]) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 8/ 27. ([2]) إحياء علوم الدين، الغزالي، 3/ 54، 55. ([3]) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 10/ 300. وأوضح القرطبي أن المعنى: وَإِنْ كَادُوا لَيَرْكَنُونَكَ، أَيْ كَادُوا يُخْبِرُونَ عَنْكَ بِأَنَّكَ مِلْتَ إِلَى قَوْلِهِمْ، فَنَسَبَ فِعْلَهُمْ إِلَيْهِ مَجَازًا وَاتِّسَاعًا، كَمَا تَقُولُ لِرَجُلٍ: كِدْتَ تَقْتُلُ نَفْسَكَ، أَيْ كَادَ النَّاسُ يَقْتُلُونَكَ بِسَبَبِ مَا فَعَلْتَ، ذَكَرَهُ الْمَهْدَوِيُّ. وَقِيلَ مَا كَانَ مِنْهُ هَمٌّ بِالرُّكُونِ إِلَيْهِمْ، بَلِ الْمَعْنَى: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ لَكَانَ مِنْكَ مَيْلٌ إِلَى مُوَافَقَتِهِمْ، وَلَكِنْ تَمَّ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ فَلَمْ تَفْعَلْ، ذَكَرَهُ الْقُشَيْرِيُّ.