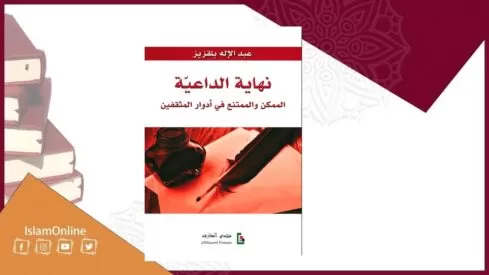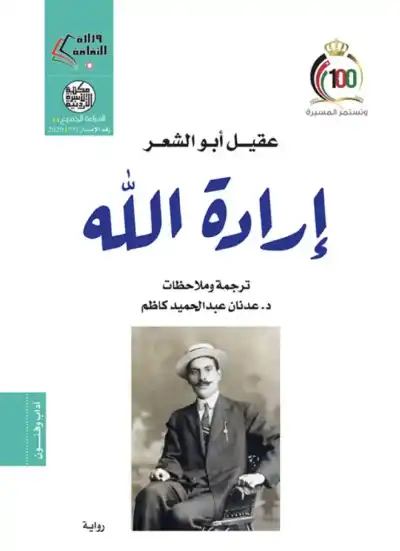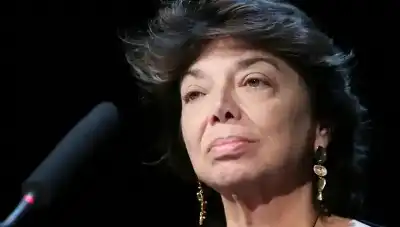مدار الساعة - يناقش الباحث عبد الإله بلقزيز في كتابه (نهاية الداعية: الممكن والممتنع في أدوار المثقفين) قضايا ثقافية مطروحة في الحقل الثقافي العربي المعاصر، تتعلق بفكرة التزام المثقف، وأمراض المثقفين، والممكن والممتنع في أدوار المثقفين، ومظاهر تهميش المثقف العربي قديماً وحديثاً، وقد تناول الباحث تلك القضايا من خلال أربعة فصول رئيسة بطريقة منهجية.
دعا المؤلف من خلال هذا الكتاب المثقفَ العربي إلى إنجاز الثورة الثقافية قبل الثورة الاجتماعية، كما دعا إلى العمل على مراجعة الإنتاج المعرفي لدى المثقفين العرب، وتجاوز عقبة العطب في الإنتاج، وعلاج الأمراض الثقافية التي تفتك بجسم الثقافة العربية وتنخر عقل المثقف العربي، سعياً إلى إيجاد توازنٍ نفسي للثقافة العربية، وإنتاج خطاب عربي سويّ يُعلي من شأن الثقافة العربية، لتكون دائماً في صدارة ثقافات الأمم.
والواضح أن الكتاب الذي نحن بصدد الحديث عنه أثار جدلاً في أوساط المثقفين العرب فور صدوره، حيث كانت هناك مواقف متباينة بخصوص القصد من هذا الكتاب، فزعم البعض أنه عبارة عن "وثيقة إدانةٍ للمثقفين وإعلان وفاة للمثقف" وإساءة لفكرة الالتزام، وقد دفع هذا الجدل المؤلف إلى أن يقول -في مقدمة الطبعة الثانية لكتابه- إنه يسلِّم بحق القارئ في فهم مضمون هذا الكتاب "على النحو الذي شاء أو أمكنه فهمه".
لكن الملاحظ أن المؤلف لم يقتصر على إعلان التسليم للقارئ بحق فهم مضمون الكتاب، بل سارع إلى توضيح أمرين: الأول أنه لم يقصد من هذا الكتاب الإساءة إلى صورة المثقفين العرب بل أخضع خطاباتهم للتحليل متوسلاً بمفاهيم علم النفس المَرَضي من أجل فهم وجوه عدم "السواء" واختلال التوازن، أما الأمر الثاني فهو أنه لم يقصد الإساءة إلى فكرة الالتزام على أي نحو صريح أو مضمَر[1].
أمراض المثقفينفي الفصل الأول، يحدثنا المؤلف عن ما يسميه "مفارقات اللاتوازن"، فيقول إن من أبرز مفارقات المثقف العربي أنه لا يَكُفٌّ عن تكرار "متلازمة رتيبة فارغة من فرط الترداد: انطواءُ فِعلِه الثقافي (أو الفكري) على دور عظيم في المجتمع والتاريخ"[2]، كما أنه "ينتدب نفسه لأداء أدوار اجتماعية يعجز عن النهوض بها"[3]، ونجده مع الشعب وضده.
ويبدو أن المفارقات التي تُحيط بالمثقف العربي عبارة عن أعراض لبعض الأمراض الثقافية الخطيرة، والحقيقة أن المرض لا يصيب الإنسان فقط (المثقف)، بل يصيب الثقافات والحضارات أيضاً، حيث "يَعرِض لأحوال الثقافة من تبدُّل في المنازع والمزاج ما يَعرِض لأحوال الفرد، فتخلد حيناً إلى الدعة والاطمئنان، وتصيبها دهراً عوارض التوتر والقلق"[4].
والظاهر أن المثقفين العرب قد أصيبوا بأمراض عديدة شكلت عائقاً دون قيامهم بالدور المطلوب منهم للنهوض بالثقافة العربية والمجتمع العربي، وقد تعرض المؤلف لأربعة أنواع من أمراض المثقفين يمكن إجمالها في: النرجسية الثقافية (حب الذات المَرَضي)، والسّادية الثقافية (الانتشاء بتعذيب الآخرين)، والمازوشية (تعذيب الذات على نحو أليم)، والفوبياء الثقافية (الخوف من خطر معلوم أو مجهول المصدر)[5].
ولعل هذه الأمراض الخطيرة هي التي دفعت المؤلف إلى الدعوة إلى ضرورة العمل لإيجاد توازن نفسي للثقافة العربية يؤدي إلى إنتاج خطاب عربي سويٍّ، ولعل من أهم الأمور التي يمكن أن تساعد في تحقيق هذا الهدف: شفاء المثقفين من تلك الأمراض، واعتماد منهج التحرر الذاتي الذي "يبدأ من إخضاع الأفكار إلى محاكمة المعرفة والواقع وتأسيس الحوار والمخاطبة والنقد على معطيات الحكمين: المعرفي والواقعي، ومحاسبة النفس على قدر طاقة الفعل الذاتي"[6].
مراجعة الإنتاج المعرفييدعو المؤلف من خلال الفصل الثاني إلى مراجعة شاملة للإنتاج المعرفي لدى المثقفين وأدوارهم الاجتماعية، وقد خصص في هذا الفصل محوراً تحت عنوان: (المثقف المأزوم أو نهاية الأساطير)، حيث ذكر أن هناك ثلاثة من الأوهام والأساطير تحتاج إلى وقفة نقدية في معرض هذه المراجعة المطلوبة، وهي: أسطورة الدور الإرشادي، وأسطورة الدور الرسولي، وأسطورة الدور العلمي المحايد.
وفي هذا الإطار، حدثنا المؤلف عن "نهاية الإقطاع المعرفي"، حيث كان المثقف العربي يقدم نفسه للجمهور "بوصفه الكائن الاجتماعي الحامل لرأسمال متميز هو المعرفة"، كما حدثنا عن ما يسميه "ورطة الداعية" التي تعني أن كل مثقف عربي يكاد يكون مسكوناً بهاجس رساليٍّ ويعيش في ظل "هوس رسولي"، هذا بالإضافة إلى ظاهرة انصراف المثقف عن الشأن العام واعتكافه على الدرس والتحصيل، "لإنتاج معرفة غير مرتهنة للممارسة أو للطلب العام".
وقد ذهب المؤلف إلى أننا عندما نفتح ملف مراجعة الإنتاج المعرفي تستوقفنا ظواهر ثلاث تغري بالنقد، أولها ظاهرة التراكم المعرفي، فـ "المثقف العربي يعاني من فقر معرفي مزمن يؤثر تأثيراً حاسماً في قدرته على الإنتاج والإبداع والعطاء"، وهذا الفقر الرهيب يمثل عائقاً حقيقياً أما عملية تقدم عملية الإنتاج والإبداع.
الظاهرة الثانية تتمثل في مضمون الإنتاج الفكري، الذي يكشف عن أن المثقفين العرب يعانون من عقم في المحتوى، ويؤكد هذا العقم وجود جملة من النزعات المَرَضية لدى المثقفين، مثل: النزعة الإيمانية الوثوقية، والنزعة النصية المغلقة، ويعني ذلك أن "خطاب المثقفين العرب خطاب وثوقي مطلق، الأفكار فيه منزَّهة عن الشك واليقين، متشبّعة بوهم (الامتلاك) المعرفي للحقيقة"[7].
أما الظاهرة الثالثة فتتعلق بالأنماط المختلفة لتوظيف ثقافة المثقفين العربي واستثمارها في الحقل الاجتماعي، إذ يبدو أن معظم المثقفين العرب "أنتجوا ممارستهم الفكرية بما يجافي دورَهم المفترض: تخلوا عن وظيفة التنوير والإبداع والنقد، وانصرفوا عنها إلى ممارسة وظيفة التبرير والتسويغ والشرعنة"[8].
طبيعة أدوار المثقفينماذا تبقى من دور للمثقفين؟ قد يكون هذا السؤال من أبرز الأسئلة التي لا تغيب عن أذهان المثقفين العرب، وقد ذكر المؤلف في الفصل الثالث أن السبب في ذلك يعود إلى "أن قدراً من الشك دبَّ في اطمئنانهم إلى دورهم التقليدي الذي أدَّوْهُ في مراحل ماضية"، كما أنه قد يرجع أيضاً إلى حقيقتين متلازمتين، تتمثل الأولى في التداعي الذي أصاب مركز المثقف في التراتبية الاجتماعية، أما الثانية فتتمثل في تداعي بضاعة المثقف أمام منتجين جدد[9].
وهذا الأمر يدعونا إلى تقديم تفسيرٍ أكثر وضوحاً يتمثل في التصريح بأن المثقف العربي يعاني من مشاكل عديدة، ويحس بأشكال مختلفة من التهميش: التهميش الاجتماعي – الاقتصادي، والتهميش الثقافي، فالأول يتمثل في فقدان المثقفين لمركزهم الأثير في التراتبية الاجتماعية الجديدة، وانهيار وضعهم الاقتصادي والمعاشي، أما التهميش الثقافي فيعبّر عن الاستغناء المتزايد عن خدمات المثقف المعرفية التي قدَّمها في ما مضى[10].
ولا شك أن هذا التهميش الشامل سيدفع المثقف العربي إلى التعبير عن "مشاعر الإحباط تجاه ما يَلقاهُ من معاملة غير مُنصفة"، فيبدو مضطراً إلى أن ينظر بعين الحسرة إلى موقعه الهامشي في التراتبية الاجتماعية العامة وفي وعي الجمهور أيضاً، ونحن نعتقد أنه قد يكون من غير المريح -بالنسبة للمثقف المعاصر- القول إن شعور المثقف بالظلم والحيف ليس ظاهرة جديدة، بل تعبر عن "شعور قديم لازَمَ حَمَلَة القلم وكل ذي رأي منذ غابر العصور"[11].
ومهما يكن من أمر، فإن دور المثقف العربي ما زال مطلوباً ولكنه ليس دوراً نبوياً ولا رسولياً، وهذا ما نجد عبد الإله بلقزيز يُصرّح به بشكل واضح عندما يقول: "في مضمار الحديث في المعرفة وفي الدور المعرفي للمثقفين، سيكون من باب ترويج الأوهام -أيضاً- تقديم هذا الدور وكأنه دور نبوي: النطق بالحقيقة، وهو للأسف ما توطَّن الاعتقاد به لمرحلة طويلة لدى الجمهور ولدى المثقفين أنفسهم"[12].
التزام المثقفافتتح المؤلف الفصل الرابع بالحديث عن أهمية إعادة تأسيس معنى جديد لفكرة "التزام المثقف"، وقال إن أول خطوة نحو هذا الاتجاه تتمثل في أن يكفَّ المثقف عن تضخيم دوره التاريخي، وأن يُقْلِعَ عن عادة انتداب النفس لأداء مهمات أعظم من حقل الثقافة ذاته، وأن يعتاد على ممارسة الأدوار التي تُناسب موقعه وحجمه في السلم الاجتماعي للقوة، وأن يعتاد على إقامة الفاصل بين ما يستطيع إنتاجه من معارف وأفكار وما يملك أن يقوم به من على سبيل تحويل تلك الأفكار إلى حقائق مادية[13].
وفي سياق الحديث عن السياسة الثقافية وما تبقى من دور للمثقفين العرب، أوضح المؤلف أن أكبر التحديات التي تواجه المثقفين اليوم تتمثل في "حماية الأمن الثقافي من مخاطر الاستباحة الخارجية التي تحْملها لهم التحولات والثورات العلمية الجديدة"[14]، وأن المثقفين معنيّون -أكثر من غيرهم- بحماية السيادة الثقافية والرمزية، والدفاع عن الثقافة الوطنية والقومية، مشيراً إلى أن هناك ثلاث مهمات تؤكد أن دور المثقفين ما زال مطلوباً، وهذه المهمات هي: المهمة المعرفية العلمية (التنوير)، والمهمة الاجتماعية (الحرية)، والمهمة الوطنية.
وقد ختم المؤلف كتابه بالتأكيد على ضرورة إنجاز المثقف العربي لـ "الثورة الثقافية" أولاً قبل أي ثورة أخرى، إذ "لم يَعُدْ مقبولاً منه أن يَنذر نفسه لقضية الثورة الاجتماعية والسياسية وهو لم يُنجِز بعدُ الثورة المطلوبة منه: الثورة الثقافية، الثورة التي تقاوم الجهل والأمية وسائر الأفكار والأوهام التي تصنع الحواجز أمام إمكانية التقدم الإنساني"[15].
بقي علينا أن نقول إنه بعد كل ما أصاب الثقافة العربية والمثقفين العرب من أمراض استمرت لعقود طويلة، قد يكون من الجائز لنا أن نتساءل في ختام هذه المقالة، فنقول: هل حان موعد الإعلان عن وفاة المثقفين العرب؟ أم أنّ علينا تجديد الثقة للمثقف مجدداً والبدْءُ في البحث عن علاجٍ أو لقاحٍ للأمراض الذي انتشرت في جسم الثقافة العربية وفتكت بعدد هائل من الأفكار والمثقفين؟ كي نخرج من الأزمة الصحية، فيُنجز المثقف العربي ثورة ثقافية تخدم الثقافة العربية وتُعلي من شأنها بين الثقافات الأخرى.
[1] عبد الإله بلقزيز، نهاية الداعية، 25-26. [2] المصدر نفسه، 50. [3] المصدر نفسه، 52. [4] المصدر نفسه، 55. [5] للتوسع، انظر، المصدر نفسه، 55-66. [6] المصدر نفسه، 69. [7] المصدر نفسه، 76. [8] المصدر نفسه، 78. [9] انظر، المصدر نفسه، 117. [10] انظر، المصدر نفسه، 118. [11] المصدر نفسه، 139. [12] المصدر نفسه، 134. [13] انظر، المصدر نفسه، 149. [14] المصدر نفسه، 155. [15] المصدر نفسه، 175.