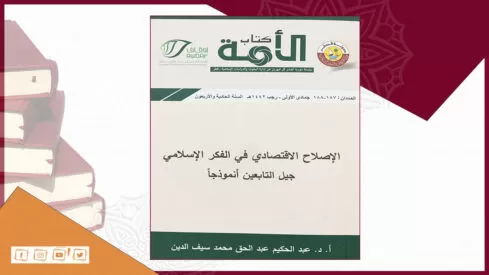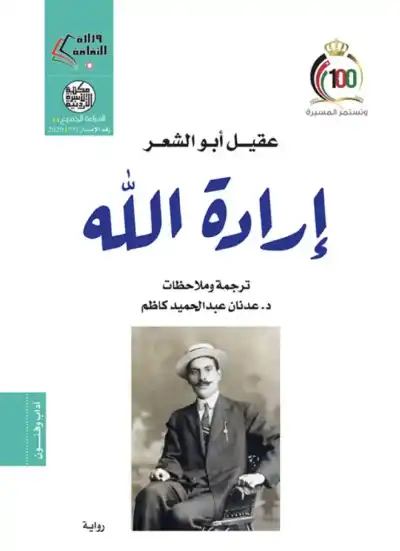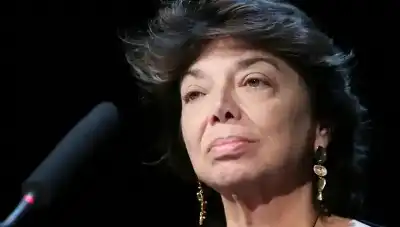مدار الساعة -
يشهد العالم منذ فترة تحولات اقتصادية مختلفة وهزّات عنيفة، أدت إلى سقوط منظومات اقتصادية كالاشتراكية، وظهور العديد من الأزمات الاقتصادية العالمية التي تنذر بانهيار بعض المنظومات الاقتصادية كالرأسمالية، وفي ظل هذه التحولات والهزّات العنيفة تبدو الحاجة ماسّة إلى ما يمكن تسميته بـ"الإصلاح الإقتصادي في الإسلام"، وإلى نظام اقتصادي شامل وموضوعي وغير عنصري، يقوم على الرفق والعدل والإنصاف والمساواة، ويحرّم الربا وينبذ التبذير والإسراف.
وفي محاولة للتأكيد على ضرورة العمل من أجل اعتماد نظام اقتصادي متكامل شامل، في سياق الإصلاح الإقتصادي في الإسلام، أتي العدد الجديد من سلسلة (كتاب الأمة) الصادر حديثاً (فبراير 2021) عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر تحت عنوان: (الإصلاح الاقتصادي في الفكر الإسلامي.. جيل التابعين أنموذجاً)، للباحث اليمني عبد الحكيم عبد الحق محمد سيف الدين، وقد قسم الباحث كتابه إلى ثلاثة فصول تتناول: الأوضاع الاقتصادية في صدر الإسلام، والأوضاع الاقتصادية في العصر الأموي، وموقف كبار التابعين من الأوضاع الاقتصادية في العصر الأموي.
مارس الباحث من خلال هذا الكتاب الخاص بالإصلاح الإقتصادي في الإسلام، وهو كتاب مهم، عملية استدعاء تاريخي لموقف جيل التابعين باعتباره يمثل "معيارية إسلامية" لقياس التحولات التي يشهدها العالم، وتأخذ هذه المعيارية قيمتها ومشروعيتها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)، ومن هنا فإن هذا الكتاب "يقدم مقاربة تاريخية لما تعانيه الأمة اليوم والعالم من تحولات اقتصادية تستدعي جهداً إسلامياً من أهل الاختصاص، لاستيعاب القضايا الاقتصادية المعاصرة"[1].
الأوضاع الاقتصادية في صدر الإسلاميبدو جلياً أن نظرة الإسلام إلى المال شاملة وعادلة، "فملكية الإنسان للمال ملكية انتفاع ناتجة عن الكسب المشروع، ولم يترك الإنسان عند حدود كسب المال، بل طالبه بحسن إدارته والتقوى في التصرف فيه"[2]، إذ سوف يُسأل الإنسانُ يومَ القيامة عن أربع منها "وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه"، وقد ساهمت تلك النظرة الشاملة العادلة في تنوع وتطور موارد الدولة الإسلامية عبر التاريخ، ففي العهد النبوي تمثلت موارد الدولة في (الزكاة والغنائم والجزية)، أما في عصر الخلفاء الراشدين فشهدت موارد الدولة تنوعاً ملحوظاً، حيث ظهرت موارد أخرى، مثل: الخراج، وعشور التجارة، والصوافي (وهو ما اصطفاه الإمام لنفسه من أموال العدو قبل القسمة).
والواضح أن أساليب الجباية كانت من أبرز الأمور التي كشفت عن عدالة الإسلام ورحمته، حيث "كان الرفق والتحري والإنصاف هو الاتجاه العام في تعامل الدولة مع أهل الذمة في صدر الإسلام"، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم أهل الذمة فقال: "من ظلم معاهداً أو كلَّفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة"، وكان من أبرز مظاهر الرفق بأهل الذمة أخذ الخراج من جنس ما ينتجون، حيث أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة في اليمن الثياب المعافرية بدلاً من الدنانير، فأصبح الرفق في الجباية عادة عند الخلفاء حتى في العصر الأموي.
ويبدو أن الأنشطة الاقتصادية في صدر الإسلام كانت تقتصر على الزراعة والتجارة والصناعة، حيث اكتسبت التجارة أهمية خاصة لدى المسلمين تجلّت في (إحياء الموات، والإقطاع، وتنظيم وتوزيع المياه)، أما الصناعة فإن العرب كانون يحتقرون الأعمال اليدوية لذلك تركّزت في أيدي العبيد والموالي، وعندما جاء الإسلام ركّز على معالجة هذه الظاهرة، فقام بتبيان قيمة العمل وأهمية الحرفة، فتوجه كثير من الصحابة إلى الاهتمام بالحِرَف الصناعية.
وقد كان تعامُل الخلفاءِ الراشدين مع المال العام واضحاً جداً، حيث كانوا يفرّقون بين أموالهم الخاصة وأموال الدولة، فقد رفض عمر بن الخطاب أخذ جارية اختارها له بعض الصحابة من الفيْء لأنها من مال المسلمين، كما اتخذ الصحابة إجراءات حازمة ضد العابثين بالمال العام دون تمييز بين قريب وبعيد، حيث منع أبو بكر الصديق رضي الله عنه إعطاء أرض فدك لفاطمة الزهراء رضي الله عنها، لأن هذه الأرض أصبحت -بعد موت النبي- ملكاً لجميع المسلمين[3].
الأوضاع الاقتصادية في العصر الأموييمكن القول إن النظرة إلى المال في العصر الأموي لم تختلف كثيراً عن النظرة إليه في صدر الإسلام، فقد كان الخلفاء الأمويون ينظرون إلى المال بوصفه وسيلة لتحقيق المنافع الدنيوية والأخروية، ولكن يبدو أنه كان هناك اتجاهان في هذا العصر، الاتجاه الأول يبالغ في الإنفاق على مصالح الدولة ويمثله (مثلاً): معاوية بن أبي سفيان، ويزيد بن معاوية، وقدم لنا معاوية صورة موجزة عن سياسته المالية فقال: "ضبطت رعيتي بالحلم والحجا، وتودّدت ذوي الضغن بالبذل والعطاء، واستملت العامة بأداء الحقوق".
أما الاتجاه الثاني فاعتمد سياسة ترشيد الإنفاق وإيقاف الهبات ويمثله (مثلاً): عمر بن عبد العزيز وعبد الله بن الزبير، فقد روى الذهبي أن عبد الله بن الزبير كان إذا كتب لأحد بجائزة ألف درهم جعلها أخوه مصعب مائة ألف، أما عمر بن عبد العزيز فكتب إلى والي المدينة قائلاً: "وقد قطعنا لك دون ما كان يقطع لمن كان قبلك، فأدق قلمك وقارب بين أسطرك واجمع حوائجك، فإني أكره أن أُخرج من أموال المسلمين مالا ينتفعون به".
ويبدو أن موارد الدولة الأموية كانت متنوعة، إذ تمثلت في الزكاة والجزية والخراج وخمس الغنائم وعشور التجارة، بالإضافة إلى مصادر متفرقة، مثل: هدايا النيروز والمهرجان، وثمن الصحف، وأجر الفيوج، وجوائز الرسل، وأجور الجهابذة، إلا أن عمر بن العزيز اعتبر أن هذا النوع من الهدايا (مظالم) يجب إزالتها[4].
وقد شهدت الأنشطة الاقتصادية تغيرات عديدة، حيث أعطى الخلفاء الأمويون الزراعة أهمية كبيرة، فحفر معاوية عدداً من الأنهار، وحفر الحجاج بن يوسف النيل والزابي، وحفر هشام بن عبد الملك نهر الهني، ولم يعد هدف الإقطاع مقتصراً على استصلاح الأرض وعمارتها، بل أصبح يستخدم "لكسب المعارضين وتأليف قلوبهم، واتخذ مكافأة للقادة والأمراء، وأعطي للمرابطين في الثغور.. إلخ"[5].
أما التجارة فشهدت تطوراً كان من مظاهره ظهور أنظمة جديدة لتسهيل التبادل التجاري، مثل: السفاتج (الحوالة)، والشركات والوكالات التجارية[6]، كما شهد قطاع الصناعة تطورات عديدة، ففي مجال صناع المنسوجات حرص كثير من الخلفاء الأمويين على ارتداء الثياب الفاخرة، وأصبحت دمشق مركزاً لكثير من الصناعات كصناعة الزجاج والخزف والحرير، وازدهرت صناعة المعادن، وساهمت وفرة الحديد في تطور صناعته، وتطورت صناعة الأوراق في بلاد الشام[7].
وكان ظهور العملة الإسلامية من التطورات الاقتصادية المهمة التي شهدها العصر الأموي، حيث "وجه عبد الملك بن مروان أوامره إلى الحجاج سنة 74 هـ بضرب الدراهم الإسلامية في العراق بدلاً من الدراهم الفارسية، ثم ضرب هو الدنانير في دمشق أواخر سنة 75 هـ، ثم أمر بتعميمها في جميع الأمصار سنة 76 هـ"[8]، وقد حرص الخلفاء الأمويون على حماية العملة الإسلامية من العبث والتزييف وإنقاص الوزن، ولذلك أخذ مروان بن الحكم رجلاً يقطع الدراهم فقام بقطع يده.
نظرة كبار التابعين إلى المالأعطى كبار التابعين المال أهمية كبيرة وعملوا على تحصيله وتنميته واهتموا بتوجيه الناس إلى الاهتمام به لكن مواقفهم كانت متباينة، فهذا سعيد بن المسيب يحدد أهمية المال في التقرب إلى الله تعالى والاستغناء عن الناس، فيقول: "لا خير فيمن لا يحب المال، يصل به رحمه، ويؤدي به أمانته، ويستغني به عن خلق ربه"، وهذا الحسن البصري يعارض الانكباب على جمع المال والالتهاء به، فيقول: "بئس الرفيقان: الدرهم والدينار لا ينفعانك حتى يفارقانك".
ومن هنا يبدو أن قيمة المال عند كبار التابعين تتمثل فيما يحققه من مكاسب أخروية، لذلك نلاحظ اهتمامهم الكبير بإنفاق المال على المحتاجين، فنجد خالد بن معدان يقول: "خير مال العبد ما انتفع به وابتذله، وشر أمواله مالا يراه وحسابه عليه ونفعه لغيره"، وكان عروة بن الزبير رضي الله عنهما يفتح بستانه للناس في موسم الرطب فيأكلون ويحملون معهم.
لم تقتصر نظرة كبار التابعين إلى المال على هذا الجانب فقط، بل كانوا يعتبرون المال أداة ابتلاء للإنسان، وقد دفع هذا الإيمان البعض إلى تفضيل الفاقة على الغنى، حيث كان من أدعية طاووس: "الله احرمني كثرة المال والولد"، وقد "تحرى كبار التابعين مصدر الأموال التي اكتسبوها إلى حد أنهم كانوا يتركونها إذا داخلهم الشك فيها، فترك القاسم بن محمد مائة ألف درهم لشكه في مصدرها"[9]، وامتنع ابن محيريز عن شراء ثوب عندما اكتشف أن التاجر تعرّف عليه، فقال: "إنما نشتري بأموالنا لا بديننا".
موقف التابعين من التغيرات الاقتصاديةالواضح أن مواقف التابعين من مظاهر الإصلاح الإقتصادي في الإسلام، والتغيرات التي طرأت على الحياة الاقتصادية في الدولة الأموية كانت متباينة، فقد كان هناك فريق مؤيد وآخر معارض لتلك التغيرات، فعلى مستوى التغيرات الإيجابية استحسن بعض كبار التابعين الإجراءات التي اتخذتها الدولة، حيث نجد الحسن البصري يقول عن سياسة زياد بن أبيه: "من مثل زياد لو لا إسرافه في العقوبات وسفك الدماء؟".
وهكذا يبدو أن استحسان بعض كبار التابعين للتغيرات التي طرأت دفعت بعضهم إلى العمل والممارسة، حيث شارك كثير من التابعين في وظائف الدولة، فقد عيّن زياد بن أبيه شريحاً القاضي على بيت المال في الكوفة، وفي خلافة عمر بن عبد العزيز وليّ الحسن البصري قضاء البصرة، وكان عمير بن هانئ على خراج دمشق، وميمون بن مهران على قضاء خراج الجزيرة.
أما على مستوى التغيرات السلبية،في سياقات الإصلاح الإقتصادي في الإسلام، فقد اتخذ كثير من التابعين "مواقف رافضة لما حدث في الحياة الاقتصادية من انحرافات في العهد الأموي"[10]، وتمثل منهج كبار التابعين في الوقوف ضد المتغيرات السلبية في أمور عديدة، منها: التغيير باليد، والتغيير بالكلمة، والتغيير بالقلب، والانسحاب من وظائف الدولة، ورفض هبات الأمراء، ومن الأمثلة على هذا المنهج أن عمر بن عبد العزيز أنكر عبث بعض أسلافه من الخلفاء، ويبدو أن الإجراءات التي قام بها عمر بن عبد العزيز ساهمت "في إعادة التوازن إلى الحياة الاقتصادية، بعد أن أصاب بعض جوانبها الانحراف"[11].
وقد ختم المؤلف كتابه بالتأكيد على الحاجة الماسة إلى دراسات معقمة حول حياة المجتمع الإسلامي في القرون الأولى، من أجل أن تدبّ فيها الروح وتكون نموذجاً يحتذى، كما أوصى بدراسة العهد دراسة متجردة من أجل إنصاف تلك الحقبة التاريخية التي كان لها دور في الحفاظ على ثوابت الأمة والتكيف مع المتغيرات داخل إطار الثوابت.
[1] عبد الحكيم عبد الحق محمد سيف الدين، الإصلاح الاقتصادي في الفكر الإسلامي.. جيل التابعين أنموذجاً، 8. [2] المصدر نفسه، 10-11. [3] انظر، المصدر نفسه، 83-85. [4] انظر، المصدر نفسه، 130. [5] المصدر نفسه، 205. [6] انظر، المصدر نفسه، 213-216. [7] انظر، المصدر نفسه، 217-220. [8] المصدر نفسه، 222. [9] المصدر نفسه، 265. [10] المصدر نفسه، 283. [11] المصدر نفسه، 295.