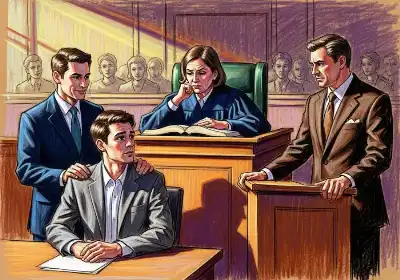بقلم د.رامي أبونفاع
حين يُصاغ الألم حرفاً، وحين ينطق الوجع فكراً، وحين يُحال التهجير القسري عودًا نهائي للوطن، نتيقنُ حينها أننا أمام المفكر فهمي جدعان، ذلك الطفل الذي لم يشكل حدث ولادته في هذه الدنياً تاريخاً يستحق التذكر، بات حرفُه علامةً فارقة في دُنيا الفكر والفلسفة، وبعد قراءة سيرته المحكية التي صاغها بروح روائية أكاد أجزم انه كان يُغيّب الأديب بداخلة على حساب المفكر والباحث.
لا يخطر في بالِ أحد أن هذه المذكرات هي سردٌ تقليدي لمواقف فردية تخصه أو تخص البعض ممن حوله، إذ أنك في "حكايات جنى الخُطا والأيام" لا تقرأ التاريخ الفردي فقط، بل تقرأ وجع إنسان يُجسد وجع شعبٍ فينقل أحاسيس أطفاله وعوز أمهاته وبطولتهم في الحفاظ على أسرهم.
إنه يجسد تشتت أبناء البيت الواحد في بلدان اشقتها السياسة ورسمتها الحدود.
كيف لك يا دكتور فهمي أن تكون صريحاً حد الكشف عن مواطن ضعفك وتشوهات ذاكرتك وخيبات زمانك وضنك عيشك، جنب إلى جنب مع نير أفكارك وعظمة مؤلفاتك؟! لم تضع مؤلفاً تظهر فيه الأنا الفردية وتخلد به قصة نجاحك، وأنت الحاصل على أعلى شهادة علمية من أفضل جامعات العالم، وأنت الحاصل على الأوسمة الملكية والجوائز والتكريمات من رؤساء الدول والمؤسسات الرسمية والثقافية، وأنت من التقى وزامل وصادق خيرة مفكري عصره وأساتذة زمانه، لتصبح مؤلفاتهم ومؤلفاتك مناهج تُدرس لطلاب الفلسفة والفكر.
كان لك أن تجعل من مذكراتك تخليدًا لعظمة شأنك وريادة أفكارك وأصالتها وتفردها، لكن الإنسان الحقيقي الذي يسكنك أبى إلا أن يكون أخلاقياً ومكاشفاً وراصداً ليس لوجعك فقط، بل لوجع عين غزال والقرى المحيطة بها، إنك اختصار للألم الفلسطيني وللأمل الفلسطيني في آن.
تُقرأ "حكايات" الدكتور فهمي بالدمع ونير القلب قبل العين، يأخذك إلى وطن المخيم، أو المخيم الوطن ذلك الوطن الذي احتواه منذ أن عرفت الشمس طريقاً لجسده إلى أن بلغ الرشد عقله.
وعلى الرغم من رحيله إلى مدينة الأنوار "باريس" وارتدائه "لماركاتها" وارتياد مطاعمها والسكن في أحيائها، إلا أن ذاكرته بقيت وفية وتحن لشوارع دمشق وسوق الحميدية والمخيم ومدرسته التي أدمت قدميه في سبيل الوصول إليها، هذا الحنين الذي يسكنه، ما هو إلا تجسيداً لحال مئات الألوف من الفلسطينيين المُهجرين والمتألمين على امتداد هذه الأرض التي افترشوها وسكنوا أرقى مدنها ودولها وحملوا جنسياتها، إلا أنهم لا زالوا بلا وطن ما زالوا بلا فلسطين، فكيف يستقيم معنى الوطن دون فلسطين؟ وكيف يستقيم معنى العروبة دون فلسطين؟
إن ذاكرة الدكتور فهمي، هي ذاكرة وطنٍ وشعب، هي طريق رُسم بالفقد لطفل ما برح يفقد كل فترة من حياته جزءًا منه مرة على شكل تهجير قسري، ومرة في وداع أخت، ومرة في رحيل صديق أو مرض زوجة ليتوج ألمه برحيل أمٍ سكنته وسكنها، وأسكنها في قلوبنا جميعا.
هو طريق ابتدأه خائفا يمسك يد أمه في عتمة ليل الخروج من عين غزال، خروجاً كان مخططًا له أن يكون لأسبوع أو اثنين لا أكثر، وإذ به خروجٌ يمتد إلى ما يزيد عن نصف قرن من الزمان.
طريقا بدأه خائفا في وعيه الطفولي من الخروج آملا بالعودة، وجُل الذي أخشاه أننا جميعاً قد خرجنا في ذلك الليل دون أن نعي ذلك، فإن كان للفلسطيني وطنٌ هُجّر منه ويصبو للعودة إليه، فإننا في أوطاننا مهجرون دون أن ندرك.
حمل فهمي الشاب بداخلة أخلاقه وخجله متسلحا بهما في وجه باريس الفاضح، فما زلت قدماه أو زاغ بصره وبقى فكره كما قلبه عفيفا يصبو إلى الشهادة الأعلى في الجامعة الأهم.
حمل معه وعيه بثقل المسؤولية التي حمّلها لنفسه ولم يحمله إياها أحد، مسؤولية أن يكون كفئًا لمن سبقوه لهذه الأروقة من العرب وغيرهم، وما أدراك ما هي أروقة السوربون! لقد شكل هذا الوعي على ما أجزم هاجساً حمله معه الدكتور فهمي وانعكس على مؤلفاته التي وضعها بمستوى قل نظيره من الصرامة الفكرية وضبط المصطلح وتوثيق الأفكار وكأنه أدرك منذ الورقة الأولى التي وضعها أن مصيره التميز والتفرد فما تدرج في نتاجه بل بدأه من القمة مباشرة سواء في أطروحته الرئيسة للدكتوراه أو في الأطروحة الفرعية، أو على امتداد مؤلفاته الاحقة، وعلى الرغم من كثرة الترحال وكثرة الصدام، لم يهاون الدكتور فهمي في إنتاجه الفلسفي والفكري، حتى بات أحد مؤلفاته محط أنظار أحد كبار الأسماء في الفكر والفلسفة ليسطو عليها وينقل عنها صفحات بأكملها وأبحاث برمتها.
عاش الدكتور فهمي مرتحلا بين أروقة الجامعات، يبنى عقول طلابه ويسكن قلوبهم، ولا أدل على ذلك من عِظم محبتهم له ومحبته لهم، فلا نجد مجموعة صفحات من حكاياته إلا وقد زخرت باسم طالب هنا وطالبة هناك، وعلى الرغم من عشرات السنين إلا أن الذاكرة احتفظت بجميل كلامهم وعذب عاطفتهم ونبل مواقفهم، ولا يُستغرب ان يحمل فهمي الإنسان هذه العواطف معه أينما ارتحل وهو الإنسان المحب الحنون الوفي الذي لم ينسَ كل من كان له فضل عليه منذ طفولته إلى أخر أيام كتابته لهذه السيرة الروائية
إن الاطلاع على ذاكرة الدكتور فهمي يعنى الوقوف على البدايات، بدايات التأسيس وبدايات النضوج، بدايات المشاعر وبتأكيد بدايات الوجع والاغتراب وبدايات الرفعة والارتقاء.
هي ذاكرة تحمل في طياتها الكثير من الدموع والكثير من الحب والكثير من الوفاء والعرفان إن مذكرات طائر التمّ هي درس إنساني وأخلاقي وفلسفي بامتياز، يحمل كل القيم التي نفتقدها اليوم ونرجو أن تكون معالم الطريق للجيل القادم، إذ تشحذ الهمم وتنير العقل وتلهب القلب وتعيد توجيه البوصلة لتشير إلى الوطن والإنسان.
لقد جسد الدكتور فهمي الإنسان الحق والفيلسوف الحق والمعلم الحق، فهو لم يكن تنظيريا يرسل أفكاره من برجه العاجي معتزلا الناس، بل محايثا لهم وممارسا لإنسانيته تجاه كل من حوله، متخذا من المقهى مكانا يخط به مؤلفاته، حتى أنه لم يخلو لذاته ليستحضر ذاكرت الأيام ويدونها بل انحاز للمقهى مرة أخرى ولشرفة الفندق وإطلالته على المحيط الأطلسي.
انحاز للإنسان الذي بقي مسكونا في الحث على التركيز عليه، ليس على الصعيد الشخصي فقط بل حتى في أرائه الخاصة ورغباته الذاتية إذ كان يحث على الرواية التي تسبر أعماق الإنسان والتي ترتقي به وكذلك على صعيد المسرح والغناء وغيرها من الفنون، لقد أسس الدكتور فهمي الأحداث والتواريخ العامة في الذاكرة الشعبية على الإنسان الفرد، فتهجير عائلة فلسطينية بات أمرا أكثر خصوصية حين ذكر أسمائهم ومكان ارتحالهم وما حل بكل واحد منهم لم يعد الأمر جملة تقال لوصف واقعة، بل بات حدث يمس الانسان بصورة أكثر خصوصية وحميمية، لقد أوجد العلاقة بين القارئ والحدث الذي يغترب عنه، كذلك دخول العراق للكويت وما رافقه من انعكاس على حياة وقرارات تمس أفراد وعائلات بعينهم وهنا لا يعود الأمر عاما وسرديا فقط بل يمسى مرة أخرى فرديا وشخصيا.
الدكتور فهمي لم ينظر إلى الصورة التي اعتدنا النظر إليها بالشكل المعهود بل نظر إليها بعيون أشخاص عاشوها وتأثروا بها وكان للحدث انعكاس مباشر عليهم، وما هذا إلا تأكيدٌ على أنسنة الأحداث والتاريخ.
لقد أنسن الدكتور فهمي حتى المقاهي التي ارتادها وذكر أسماء العاملين فيها.
أمراً كان يمكن ألّا يتوقف عنده أي منا، لكن طائر التمّ المسكون بالذكرى والفقد والنفي والألم، أبى إلا أن ينقل معه في رحلته الخاصة من اللامرئي إلى القمة، كل لا مرئي في طريقه إلى القمة.