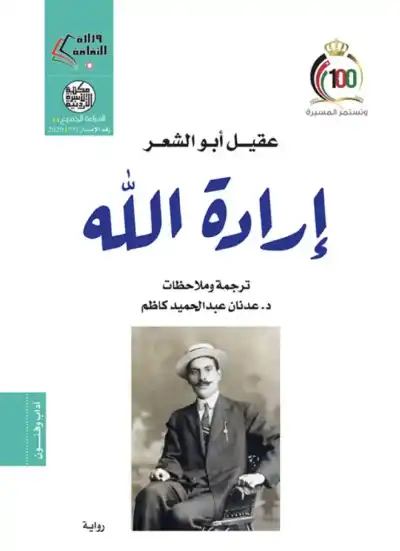مدار الساعة - د. أنس وكاك
ونعني بالاستدلال تقرير الدليل لإثبات مدلول المحور المذكور، ونعني بالخبر، خبر الشرع الذي هو الدليل النقلي، وهو الكتاب والسنة، ومطلوبهما هو مدلولهما، وقد يكون حكما شرعيا أو غير ذلك مما يتعلق بغاية التشريع ومقصده.أما السياق: فهو المتعلق والبعد والمجرى الذي يأتي الكلام منصبا فيه، فسياق الكلام أسلوبه ومجراه الذي يجري فيه.
ومعرفة السياق من طرق استقراء المعاني والدلالات عند الأصوليين وعلماء العربية، والقاعدة الأم عندهم في هذا الباب هي: الحكم بالمدلول المسوق فيه على المراد من المسوق؛ أي على دلالته وما يستفاد منها على الوجه الراجح لا المرجوح والمحتمل.
وقد رد العلماء الراسخون وجوها كثيرة من الاستدلال المفيد لمراد المستدل ظاهرا بحكم السياق وسبب الورود.
فمثلا من المعاني المتبادرة إلى الذهن الذم المنسوب للشعراء في قوله تعالى: ﴿والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون﴾ (الشعراء: 223-225)، والحقيقة أنه ليس الكلام ذما للشعراء بحكم السياق والقرينة.
فالسياق هو نفي دعوى المشركين القائلة ببشرية القرآن واختلاقه، والسياق يبدأ من قوله تعالى:﴿وما تنـزلت به الشياطين﴾[1]، ففيه نفي لتقوّل القرآن وعدم إنـزاله لا ذم للشعراء مطلقا؛ إذ في الشعر من الحِكم والأمثال وبدائع القول ما لا يأتي عليه المداد عدا، وذلك بقرينة قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن من الشعر لحكمة)[2]، أي: قولا صادقا مطابقا للحق.
قال الإمام الألوسي في "روح المعاني"[3]، في سياق تفسيره للآيات السابقة: "الظاهر من السياق أنها نـزلت للرد على الكفرة الذين قالوا في القرآن ما قالوا".
ومن أمثلة تحكم السياق في السنة ما يظهر من عدم تفاضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من ظاهر حديث: (لا تفضلوا بين الأنبياء)[4]، والسياق في مجال ذم التفاخر والمباهاة بذلك لا في نفي وجود الفضل المعلوم كونه والاجتباء المذكور في القرآن، ومنه: ﴿تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض﴾ (سورة البقرة: 223)، وغيرها من الآيات.
قال الإمام أبو سليمان الخطابي في "معالم السنن"[5]: "معنى هذا ترك التخيير بينهم على وجه الإزراء ببعضهم؛ فإنه ربما أدى ذلك إلى فساد الاعتقاد فيهم والإخلال بالواجب من حقوقهم وبفرض الإيمان بهم، وليس معناه أن يعتقد التسوية بينهم في درجاتهم، فإن الله سبحانه قد أخبر أنه فاضل بينهم، فقال: ﴿تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات﴾.
والسياق من حيث هو قرينة كبرى أو مجموعة قرائن صغرى ينقسم قسمين: سياق لغوي (مقالي) يعتمد على القرائن اللغوية التي يتضمنها الدليل ويستدل بها على مدلوله من جهة اللفظ والمعنى لتحديد المعنى اللغوي، أو ما يعبر عنه البعض بالمعنى النحوي أو الوظيفي للجملة، ألا ترى إلى العرب حين قالت: خرق الثوبُ المسمارَ، لم يعتبروا بقرينة الإعراب في دلالتها على المعنى النحوي للجملة، وذلك لوضوحه، وهو ما يسميه اللغويون بـ"أمن اللبس"، لدلالة قرينة الإسناد والمعنى المعجمي المناسب لمادة خرق.
وسياق غير لغوي (مقامي) يعتمد على سائر القرائن الأخرى المرتبطة بالـدليل والمدلول لتحديد مراد المتكلم بحسب مقتضى الحال، وهذا المعنى المقصود في خطاب المتكلم هو ما يعبر عنه البعض بالمعنى الوظيفي المراد من الخِطاب، ومقتضى الحال يشمل عناصر كثيرة تتصل بالمخاطِب والمخاطَب وسائر الظروف التي تحيط بالخِطاب، وهذا قدر زائد على مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة، ألا ترى إلى اختلاف الغاية التي تساق من أجلها القصة في القرآن، فتذكر بعض معانيها الوافية بالغرض في مقام، وتبرز معان أخرى في سائر المقامات حسب اختلاف مقتضيات الأحوال.
فالنمط التركيـبي للجملة قد يتعدد معناه الوظيفي بتعدد احتمالات الدلالات في القرائن اللغوية المقالية، فيصبح النمط التركيـبي بحاجة إلى اعتبار القرائن المقامية لرفع تلك الاحتمالات وتحديد المعنى المراد، ولذلك قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي في "موافقاته"[6]، في سياق استدلاله على أهمية أسباب التنـزيل في فهم الكتاب الذي هو أصل أدلة الأحكام: "والدليل على ذلك أمران: أحدهما: أن علم المعاني والبيان الذي يُعرف به إعجاز نظم القرآن فضلا عن معرفة مقاصد كلام العرب إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال، حال الخطاب من جهة نفس الخطاب، أو المخاطَب، أو المخاطِب، أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين، وبحسب مخاطبين، وبحسب غير ذلك، كالاستفهام لفظه واحد، ويدخله معان أخـر من تقرير وتوبيخ وغير ذلك، وكالأمر يدخله معنى الإباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها، ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة، وعمدتها مقتضيات الأحوال، وليس كل حال ينقل، ولا كل قرينة تقترن بنفس الكلام المنقول، وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة، فات فهم الكلام جملة أو فهم شيء منه، ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل من هذا النمط، فهي من المهمات في فهم الكتاب بلا بد، ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال،..".
وقد أحسن رعاية هذا المعنى من المعاصرين الدكتور تمام حسان في دراسته اللغوية الرائعة "البيان في روائع القرآن[7]، فإنه بعد استشهاده بأمثلة تطبيقية متعددة من روائع القرآن في اعتبار قرينة السياق في تحديد المعنى المراد من النص، وبيان اعتماد هذه القرينة على مختلف القرائن من داخل النص وخارجه، قال: "وهكذا تمتد قرينة السياق على مساحة واسعة من الركائز، تبدأ باللغة من حيث مبانيها الصرفية وعلاقاتها النحوية ومفرداتها المعجمية، وتشمل الدلالات بأنواعها من عرفية إلى عقلية إلى طبيعية، كما تشتمل على المقام بما فيه من عناصر حسية ونفسية واجتماعية كالعادات والتقاليد ومأثورات التراث، وكذلك العناصر الجغرافية والتاريخية، مما يجعل قرينة السياق كبرى القرائن بحق؛ لأن الفرق بين الاستدلال بها على المعنى، وبين الاستدلال بالقرائن اللفظية النحوية كالبنية والإعراب والربط والرتبة والتضام… هو فرق ما بين الاعتداد بحرفية النص والاعتداد بروح النص، وقرينة السياق هي التي يحكم بواسطتها على ما إذا كان المعنى المقصود هو الأصلي أو المجازي، وهي التي تقضي بأن في الكلام كناية أو تورية أو جناسا…، وهي التي تدل عند غياب القرينة اللفظية على أن المقصود هذا المعنى دون ذاك؛ إذ يكون كلاهما محتملا".
وعُني بهذا من قبلُ في دراسته الشهيرة التي أفاد منها مَن بعده، وأعني بذلك كتابه: "اللغة العربية: معناها ومبناها[8]، فإنه قال في سياق حديثه عن البنية اللغوية والقرينة اللفظية: "السياق كالطريق، لابد له من معالم توضحه، ولا شك أن مباني التقسيم وما تبدو فيه من صيغ صرفية وصور شكلية، وكذلك مباني التصريف، مع ما تبدو به من لواصق مختلفة، تقدم قرائن مفيدة جدا في توضيح منحنيات هذا الطريق، ولكن السياق حتى مع وضوح الصيغ واللواصق يظل بحاجة إلى الكثير من القرائن الأخرى التي تتضح بها العلاقات العضوية في السياق بين الكلمات".
والمتكلم في السياق من حيث هو، إما أن يقصد بكلامه السياق المقالي أو المقامي أو كليهما، وسياق كلامه الحالي هو الذي يحدد مراده من جهة السامع، فالسامع، إذن، لابد له في فهم مراد المتكلم أن يكون عارفا بالسياق وسياق السياق.
والعلـم بمدلول الدليل كما يتفـاوت فيه المخـاطبون من جهة فهمهم للـدليـل ومحيطه وسياقه الذي عايشوه، يتفاوت في فهمه مَن بعدهم بحسب وقوفهم على لوازم فهم ذلك الدليل، وبحسب ذلك تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم، ومن لوازم فهم الدليل أو فهم مراد المتكلم من كلامه العلم بالقرائن المرتبطة به جملة وتفصيلا، وهي عين السياق الذي نتحدث عنه.
ومن هذه الجهة اشتُرط الفقهُ في الراوي عند جماعة من العلماء؛ وعلّلوا ذلك بأن غير الفقيه مظِنة سوء الفهم ووضع النصوص على غير المراد منها، ونُقل عن الإمام مالك أنه ذكر ذلك من باب الاحتياط في الأحكام، وخاصة في رواية الحديث بالمعنى.
ومن هذه الجهة، أيضا، اشترط المجيزون لرواية الحديث بالمعنى أن لا يكون اللفظ الذي نقل به الراوي معنى الحديث أخفى من لفظ الحديث الأصل ولا أظهر؛ لأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة، وبالخفي أخرى، فتصرف الراوي في اللفظ من جهة الوضوح أو الخفاء قد يوهم أرجحية غير الراجح عند تعارض الأدلة.
فالسياق عند علماء الشريعة أشبه بالميزان الذي يوفق بين الدليل الشرعي ومدلوله المراد، وبالنور الذي يكشف الغُمّة عن حالة الدليل التي هي المدلولات المحتملة إذا لم يكن نصا، فيخرجه من حيِّز الإشكال إلى حيِّز الوضوح والتجلي، وبالروح التي تُضفي على الدليل حيويته ومرونته في حل المعضلات وتوضيح المجملات وتعيين المحتملات بالنسبة للمخاطَب (السامع).
والدليل الشرعي إنما يُراد أساسا للإيصال إلى معرفة الحكم الشرعي، والحكم الشرعي له مصدر، وهو الشرع، ومورد، وهو المكلف الذي يتلقاه ليمتثله.
ثم مورد الحكم -وهو المكلف- قد يكون مجتهدا يستقل بمعرفة الحكم، وقد يكون قاصرا عن ذلك، وحكم القاصر هو التقليد للمجتهد، والمجتهد لا يصح له عند جمهور العلماء أن يقول بقولين مختلفين من جهة واحدة في وقت واحد[9]، والمقلد إنما عليه أن يستفتي علماء بلده؛ لأنهم أعرف به وبقضاياه وأعراف البلد التي لا يُستطاع الاستغناء عنها، وهذا أمر لم يفرده الأصوليون بباب مستقل لوضوحه، ولذلك قال ابن القيم في "إعلام الموقعين"[10]: "لا يجوز له؛ (أي للمفتي) أن يفتي في الإقرار والأيمان والوصايا وغيرها مما يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عُرف أهلها والمتكلمين بها فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه وإن كان مخالفا لحقائقها الأصلية، فمتى لم يفعل ذلك ضل وأضل".
وهذا مثال من أمثلة اعتماد المفتي في مجال الفتوى على قرينة السياق القائم على معرفة العادات والأعراف والتقاليد، لأن هذه المعرفة أساسية في صنعة الفتيا وفقه المفتي وإصابة الحق، ويفتقر فهم نص سؤال المستفتي إليها، والمفتي إذا كان جاهلا بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم سيفتي الناس بمجرد المنقول المجرد عما يشهد بسلامة العمل به.
فالمعرفة بالأحكام الشرعية من حيث هي ثابتة، ليس هو عين المعرفة بها من حيث هي متغيرة بحسب تنـزيلها على الوقائع؛ ولذلك قال الونشريسي في "المعيار"[11]: "تجد الرجل يحفظ كثيرا من الفقه ويفقهه ويعلمه غيره، فإذا سئل عن واقعة لبعض العوام من مسائل الصلاة، أو مسألة من الأعيان لا يحسن الجواب، بل ولا يفهم مراد السائل عنها إلا بعد عسر".
وقال ابن القيم: "ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم"[12].
وما من شك في أن اعتبار العرف والعادة في كثير من أبواب الفقه هو اعتبار للسياق المقامي من جهة اشتراط الاطراد والغلبة فيهما، فلا اعتبار بعرف ولا عادة إلا باعتبار السياق المقامي الذي يقدمهما من جهة المعنى ويشهد بسلامة العمل بهما، وقد سمى العرب المهر سياقا؛ لأنهم إذا تزوجوا كانوا يسوقون الإبل والغنم مهرا، وكانت هي الغالب على أموالهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن وقد تزوج بامرأة من الأنصار: (ما سقت إليها؟)؛ أي ما أمهرتها؟ وفي رواية: (ما سقت منها؟)؛ بمعنى البَدَل.
وكون الأحكام الشرعية تختلف باختلاف الصور الحادثة لا يعني أنها أحكام غير مشروعة أو شرع جديد كما يبدو لبعض السطحيين، فتنـزيل الأحكام على الوقائع يحتاج إلى معرفة العوارض والعوائد، والتمييز بين العوائد المستمرة والمتبدلة، والمعرفة بمآلات الأحكام والأفعال، والمعرفة بطبيعة الوقائع في أحوال فاعليها، وعلاقات تلك الوقائع مع غيرها من الأوضاع، والظروف المحيطة بتلك الوقائع الزمانية والمكانية، وهذا باب يلتبس على كثير من الناس.
وإذا كان مطلوب خبر الشرع قد بيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وتركهم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، فمعنى ذلك أن هذا المطلوب بَيِّنٌ واضح بعد اكتمال التبليغ، فلا إجمال بقي فيما كان مجملا، ولا إشكال بقي فيما كان مشكلا، وبهذا نفهم أن دراسات الأصوليين للدليل الشرعي من جهة كونه مجملا كما عند الجمهور، أو من جهة كونه مشكلا كما عند الأحناف إنما هو من باب الدراسات النظرية في أصول الفقه، ولا أقول من رياضيات فن الأصول كما في بعض المباحث الجزئية الأخرى التي يصدق عليها ذلك الوصف؛ إذ المعرفة بها لا تخلو من ثمرة.
والذي يظهر أن المجتهد حينما يستفرغ وسعه ويبذل جهده في طلب المقصود من جهة الاستدلال، إنما يُبين حكما شرعيا كان خفيا في أحشاء الدليل ودلالته وإيحاءات سياقه وظِلاله وجَوِّه العام والخاص، وهذا هو معنى استنباط الحكم الشرعي، ولذلك يرى بعض الأحناف بأنه لا فرق بين إظهار المجتهد لعلة الحكم وتطبيقه الدليل العام على أفراده، أو ترجيحه بين الأدلة عند التعارض، وأصحاب هذا الاتجاه يرون بأن وظيفة المجتهد هي بيان الحكم الشرعي وإظهاره بعد أن كان خفيا.
وتحصيل المجتهد على كل حال هو تحصيل ظني لاحتمال وقوع الخطأ في الاستدلال من جهة النظر، ومن أسباب وقوع ذلك القصور إغفال بعض قرائن السياق كما لا يخفى.
وقد استدل الإمام أحمد على عدم جواز رجوع الواهب فيما وهب بقرينة السياق المذكورة في الحديث الوارد في ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:(ليس لنا مثل السّوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه)، فأفاد صدر الحديث أن الرجوع في الهبة مثلُ سوءٍ، وقد نفاه صاحب الشرع، وما نفاه صاحب الشرع يحرم إثباته، فلزم من ذلك أن جواز الرجوع في الهبة يحرم إثباته، فيجب نفيه، وهو المطلوب.
فالاحتمالات في حالة الدليل، وترجيح إحداها على الأخرى، وكون الاحتمال الراجح هو المدلول المراد، كل ذلك متوقف على الدليل المفضي لترجيحه، وهو أنواع بحسب قرب الاحتمال وبعده، وقد يكون هذا الدليل المرجح قرينة السياق، وهذا نظير دليل التأويل الذي ينضم إلى احتمال اللفظ المؤول فيستوليان على الظاهر، فالكلام في هذا المكان كالميزان.
ويشهد لما ذكرت ما قرره أبو حامد الغزالي في "المستصفى"[13]، في طريق فهم المراد من الخطاب، وهو الفصل السادس من الفن الأول من القطب الثالث في كيفية استثمار الأحكام، قال: "ويكون طريق فهم المراد تقدم المعرفة بوضع اللغة التي بها المخاطبة، ثم إن كان نصا لا يحتمل كفى معرفة اللغة، وإن تطرق إليه الاحتمال فلا يعرف المراد منه حقيقة إلا بانضمام قرينة إلى اللفظ، والقرينة إما لفظ مكشوف… وإما إحالة على دليل العقل… وإما قرائن أحوال من إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق لا تدخل تحت الحصر والتخمين…".
وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين"[14]: "فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده، والألفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه، سواء كان بإشارة أو كتابة أو إيماء أو دلالة عقلية أو قرينة حالية أو عادة له مطردة لا يخل بها…".
وإذا أمعنا النظر في مجموع شروط النظر الصحيح التي تواضع عليها الأصوليون في باب الاجتهاد فإننا نجدها متعلقة بالسياق، فالعلم باللغة العربية ووجوه دلالاتها، ومعرفة أسباب نـزول القرآن وأسباب ورود الحديث، وإدراك مقاصد الشارع من تشريعاته وأحكامه، وغيرها من الشروط الأساسية أو التكميلية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسياق.
وإنما وجب اعتبار السياق في فهم المدلول المراد من الدليل؛ لاختصاصه بقوة في الدلالة على المدلول المراد، فهو ترجيح وتقديم لأحد المدلولين على الآخر، أحدهما هو المراد، وهو ما شهدت به قرينة السياق.
والترجيح بين المدلولين باعتبار قرينة السياق في المجال الأصولي، هو من باب القياس على الترجيح بين الدليلين المنقولين، فإننا إذا أمعنا النظر في باب الترجيح في كتب علماء أصول الفقه، سنجد السياق اللغوي منصوصا عليه ضمن المرجحات بين الدليلين، إذ الترجيح عندهم يكون، أيضا، بـ"الأحسن سياقا "؛ لأن حسن السياق دليل على رجحانه، واهتمام الراوي بما يرويه، فما كان من الأدلة أحسن سياقا واتساقا هو الذي يدل على مطلوب الخبر الصحيح، ولذلك قال الإمام مالك، رحمه الله، بأفضلية الإفراد في الحج؛ لأن حديث جابر في صفة الحج أولى من حـديث أنس الذي احتج به أبو حنيفة، رحمه الله، على أفضلية القران، لأن جابرا وصف الحج من بدايته إلى نهايته، وجاء بالحديث على سَوْقِه، وذلك يدل على حفظه وضبطه وعلمه بظاهر الأمر وباطنه، بخلاف أنس فإنه قال: قرن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل إلا لفظة واحدة يجوز عليه فيها ألا يعلم مسببها.
ومن ضوابط الترجيح عند الأصوليين أنه متى اقترن بأحد الدليلين قرينة عقلية أو لفظية أو حالية، وأفاد ذلك الاقتران زيادة ظن رُجِّح به؛ لأن رجحان الدليل هو بالزيادة في قوته أو ظن إفادته المدلول. فالرجحان صفة تقوم بالدليل كما تقوم بالمدلول بإحدى المرجحات، ومن ذلك قرائن السياق.
واختلاف الأصوليين في حكم فعله صلى الله عليه وسلم المتردد بين ما هو جبلي وتشريعي بالنسبة إلينا نحن الأمة، عند من جعلوه قسما مستقلا، إنما منشؤه تعارض الأصل الذي هو براءة الذمة؛ (أي استصحاب العدم الأصلي أو النفي الأصلي أو الإباحة العقلية)، مع الظاهر الذي هو الاختصاص النبوي بتبليغ الشرعيات، لكن بالرجوع إلى آحاد تلك الأفعال، يظهر الراجح من الأقوال، من جهة اعتبار قرائن الأحوال الدالة على الحكم الشرعي المناسب، لا من جهة اعتبار الأصل دون الظاهر أو العكس، وهذا واضح بالنسبة لحكم فعله صلى الله عليه وسلم الـمجرد المعلوم الصفة، فإن صفة ذلك الحكم تُـعرف، أيضا، من جهة قرائن الأحوال الدالة عليه، ومن القرائن الدالة على الوجوب مثلا: فعلُ الأذان والإقامة للصلاة، فإنه قد تقرر في الشرع أن الأذان والإقامة من أمارات الوجوب، ولهذا لا يُطلبان في صلاة عيدٍ، ولا كسوفٍ ولا استسقاءٍ، فيدُلان على وجوب الصلاة التي يُؤذن لها ويُقام. والقرينة الدالة على النـدب قصدُ القُربة مجردا عن دليل وجوبٍ وقرينته، والقرينة الدالة على الإباحة عدم ظهور هذا المعنى.
ومن أمثلة اعتبار الأصوليين لقرينة السياق استدلالهم بها في مسالك العلة، خصوصا في إثبات العلة بمسلك الإيماء والتنبيه، فالإيماء كما عرفه صاحب مسلم الثبوت: هو ما دل على العِلِّيَّة بالقرائن، ومن أنواعه: أن يُذكر في سياق الكلام شيء لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم[15]، كقوله تعالى: ﴿يأيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ (الجمعة: 9)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان)[16]، فلو لم يعلل النهي عن البيع بكونه مانعا وشاغلا عن السعي إلى الجمعة لكان ذكره خبطا في الكلام، وكذا لو لم يعلل النهي عن القضاء عند الغضب بكونه يتضمن اضطراب المزاج الموجب لاضطراب الفكرة الموجب غالبا للخطأ في الحكم لكان ذكره لاغيا، وذلك لأن البيع والقضاء لا منع منهما مطلقا، فلابد إذن من مانع، وليس إلا ما فهم من سياق الدليل ومضمونه من شغل البيع عن السعي إلى الجمعة فتفوت، واضطراب الفكرة لأجل الغضب فيقع الخطأ.
وفي السياق نفسه قال الإمام الغزالي في "شفاء الغليل"[17]، في تحديد المدلول المراد من آية السعي إلى الجمعة: "إنما نـزلت وسيقت لمقصد، وهو بيان الجمعة، وما نـزلت الآية لبيان أحكام البياعات، ما يحل منها وما يحرم، فالتعرض للبيع لأمر يرجع إلى البيع في سياق هذا الكلام يخبط الكلام ويخرجه عن مقصوده، ويصرفه إلى ما ليس مقصودا به، وإنما يحسن التعرض للبيع إذا كان متعلقا بالمقصود، وليس يتعلق به إلا كونه مانعا للسعي الواجب، وغالب الأمر في العادات جريان التكاسل والتساهل في السعي بسبب البيع، فإن وقت الجمعة يوافي الخلق وهم منغمسون في المعاملات، فكان ذلك أمرا مقطوعا به، لا يتمارى فيه، فعقل أن النهي عنه لكونه مانعا من السعي الواجب، فلم يقتض ذلك فسادا. ويتعدى التحريم إلى ما عدا البيع من الأعمال والأقوال، وكل شاغل عن السعي، لفهم العلة".
وعلى الجملة، فإهمال قرائن السياق في فهم الدليل كلا أو بعضا يؤدي حتما إلى الخطأ في فهم المدلول الصحيح الذي هو مطلوب الخبر، ومطلوب الخبر هو معرفة الحق بلا شك، وما كان دليله غير قاطع، فلا يمكن الوصول فيه إلى الحق قطعا، فيكون المطلوب فيه هو الأرجح فالأرجح، وذلك هو الغالب في أحكام الفروع الفقهية.
وفي بيان أهمية السياق وتوقف فهم المراد من الكلام عليه يقول البدر الزركشي في البرهان[18]، في الأمور التي تعين على المعنى عند الإشكال: "الرابع: دلالة السياق؛ فإنها ترشد إلى تبيين المجمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظيره، وغالط في مناظراته، وانظر إلى قوله تعالى: ﴿ذق إنك أنت العزيز الكريم﴾، كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير". والكلام نفسه ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، فلعله أصل لما نقله الزركشي.
فإذا انتقلنا إلى مجال تفسير القرآن، سنجد الإمام أبا حيان، رحمه الله، يؤكد على أهمية اعتبار السياق في علم التفسير، قال: "واعلم أن القرآن قسمان: قسم ورد تفسيره بالنقل، وقسم لم يرد… وأما ما لم يرد فيه نقل فهو قليل، وطريق التوصل إلى فهمه النظر في مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق، وهذا يعتني به الراغب كثيرا في كتاب المفردات، فيذكر قيدا زائدا على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ؛ لأنه اقتضاه السياق[19].
وذلك لأن اللغويين، وأصحاب المعاجم على الخصوص يتعاملون مع أصول الكلمة، ويجعلون تلك الأصول رحما بين الكلمات التي تشترك في تلك الأصول ويختلف معناها المعجمي، أما الراغب فيعتني بتحديد المعنى الوظيفي المراد من الكلمة بقرينة السياق، ولا يقف عند تعدد واحتمالات معناها الوظيفي أو المعجمي، وهذا ما عناه أبو حيان فيما يظهر.
وقريب من هذا ما ذكره الدكتور تمام حسان في سياق كلامه على تعدد المعنى الوظيفي للمبنى الواحد، قال: "فالمبنى الواحد متعدد المعنى، ومحتمل كل معنى مما نسب إليه وهو خارج السياق، أما إذا تحقق المبنى بعلامة في سياق؛ فإن العلامة لا تفيد إلا معنى واحدا تحدده القرائن اللفظية والمعنوية والحالية، وهذا التعدد والاحتمال في المعنى الوظيفي يقف بإزائه تعدد واحتمال في المعنى المعجمي أيضا"[20].
فتحقيق مبنى اللفظ على معناه المراد، أو تحقيق الدليل على مدلوله المراد إنما هو رهين بقرينة السياق، وبسبب إغفال هذا المعنى انتقد ابن تيمية جماعة من أهل التفسير بالنظر إلى مدلولات الكلام وسياقاته فقسمهم قسمين، قال: "أحدهما: قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثاني: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن، والمنـزل عليه، والمخاطب به!
فالأولون راعوا المعنى الذي رأوا من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام.
ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق، ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق.
والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا، فيكون خطؤهم فيه في الدليل لا في المدلول… وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة وأسلم"[21]. وهذا الكلام نقله السيوطي في الإتقان[22]، وقال: "إنه نفيس جدا".
والسياق في مجال تفسير القرآن لا يمكن الحديث فيه بمعزل عن علم المناسبة أو التناسب؛ لأنه قد ينظر إليه نظرة أعم، فيتجاوز المفسر النظر في لُحمة المقاطع المتصلة إلى ما هو أشمل من ذلك، وهو النظر في سياق السورة كلها، وكيف انتظمت معاني يأخذ بعضها بحجز بعض، وهو في ذلك يوضح المناسبات الخاصة بين آية وأخرى داخل السورة موضع الدرس، أي: دون أن يطغى الاهتمام بالسياق الأعم على السياق الأخص.
بل منهم من عُني بدرس التناسب والمشاكلة في القرآن كله كما فعـل الإمام أبو جعفر ابن الزبير شيخ أبي حيان، وبرهان الدين البقاعي في كتاب سماه: "نظم الدرر في تناسب الآي والسور"، والسيوطي في كتابه: "تناسق الدرر في تناسب السور".
وممن عُني به من المفسرين الإمام الفخر الرازي في "مفاتيح الغيب"، وأبو حيان في "البحر المحيط"، وهو علم غزير جدا قلت عناية العلماء به.
وممن عُني به، أيضا، من المعاصرين صاحب الظِّلال؛ فإنه نظر إلى السياقات العامة لكل سورة على حدة، وبين أن كل سورة سيقت لخدمة هدف معين، وأن جميع عناصر السورة وإن بدا بينها،أحيانا، في الظاهر شيء من عدم التناسب، فهي كلها في خدمة السياق العام للسورة.
كما أن سعيد حـوى عُني بدراسة الارتباط العضوي بين جميع سور القرآن ومحاوره ضمن موسوعته التفسيرية الكبرى: "الأساس في التفسير"، وقد استفاد من جهود صاحب الظِّلال وبعض القدماء، وأتى بلمحات ذكية في أحيان كثيرة، وهو من باب الإعجاز قلّ من طرقه.
وقد قال الفخر الرازي في تفسيره: "أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط"[23].
وقال القاضي أبو بكر ابن العربي في "سراج المريدين": "ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة، متسقة المعاني، منتظمة المباني علم عظيم، لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة، ثم فتح الله عز وجل لنا فيه، فلما لم نجد له حَمَلة، ورأينا الخلق بأوصاف البطالة، ختمنا عليه، وجعلناه بيننا وبين الله، ورددنـاه إليه[24]. وقال الإمام السيوطي في "الإتقان"[25]: "وعلم المناسبة علم شريف، قل اعتناء المفسرين به لدقته".
وقال في فصل فيما يجب على المفسر: "قال العلماء: يجب على المفسر أن يتحرى في التفسير مطابقة المفسر، وأن يتحرز في ذلك من نقص عما يحتاج إليه في إيضاح المعنى أو زيادة لا تليق بالغرض، ومن كون المفسر فيه زيغ عن المعنى وعدول عن طريقه، وعليه بمراعاة المعنى الحقيقي والمجازي، ومراعاة التأليف والغرض الذي سيق له الكلام، وأن يؤاخي بين المفردات"[26].
وقال الإمام الزركشي في "البرهان"[27]: "واعلم أنه جرت عادة المفسرين أن يبدءوا بذكر سبب النـزول، ووقع البحث: أيما أولى البداءة به: بتقدم السبب على المسبب، أو بالمناسبة لأنها المصححة لنظم الكلام، وهي سابقة على النـزول؟
والتحقيق التفصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوقفا على سبب النـزول كالآية السابقة في ﴿إن الله يامركم أن تودوا الاَمانات إلى أهلها﴾، فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب؛ لأنه حينئذ من باب تقديم الوسائل على المقاصد، وإن لم يتوقف على ذلك فالأولى تقديم وجه المناسبة".
وقال الشيخ العز بن عبد السلام: "المناسبة علم حسن، ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر، ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا برباط ركيك يصان عنه حسن الحديث فضلا عن أحسنه، فإن القرآن نـزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة، شرعت لأسباب مختلفة، وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض…"[28].
قال الإمام الزركشي: "قال بعض مشايخنا المحققين: قد وهم من قال: لا يُطلب للآي الكريمة مناسبة؛ لأنها على حسب الوقائع المتفرقة، وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنـزيلا، وعلى حسب الحكمة ترتيبا، فالمصحف كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكنون، مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف، وحافظ القرآن العظيم لو اسُتفتي في أحكام متعددة، أو ناظر فيها، أو أملاها لذَكَر آية كل حكم على ما سئل، وإذا رجع إلى التلاوة لم يتل كما أفتى، ولا كما نـزل مفرقا؛ بل كما أنـزل جملة من بيت العزة، ومن المعجز البين أسلوبه، ونظمه الباهر، فإنه ﴿كتاب أحكمت ءاياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير﴾.
قال: والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها، أو مستقلة، ثم المستقلة؛ ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك علم جم، وهكذا في السور يطلب اتصالها بما قبلها وما سيقت له"[29].
فالشيخ العز ابن عبد السلام، رحمه الله، وإن كان يستحسن هذا الفن إلا أنه لم يلحظ الترابط في المعاني التي تبدو متمايزة أو مستقلا بعضها عن بعض، وعلل ذلك بنـزول القرآن في نيف وعشرين سنة، وفي وقائع مختلفة ومناسبات متفرقة، ولكنه، رحمه الله، نسي أنه سيق كله لهدف واحد هو هداية الخلق، ولا ضير بعد ذلك في تباين الأساليب والموضوعات، والانتقال من قصص إلى موعظة، إلى تشريع، إلى عقيدة، إلى حكمة بالغة، إطنابا أو مساواة أو إيجازا حسب السياق المقامي.
وقال الفخر الرازي في "مفاتيح الغيب"[30]، في تفسيره لسورة البقرة: "ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة، وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه، فهو -أيضا- بسبب ترتيبه ونظم آياته، ولعل الذين قالوا إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك، إلا أنني رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف، غير منتبهين لهذه الأسرار، ليس الأمر في هذا الباب إلا كما قيل:
والنجم تستصغر الأبصار صورته
والذنب للطرف لا للنجم في الصغر
هذا وإن الإمام الشوكاني، رحمه الله، قد حمل في أوائل تفسيره "فتح القدير"[31] حملة شعواء على الذين ألفوا في علم المناسبة بين السور والآيات، قال: "اعلم أن كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم متكلف، وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته، واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة، بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله، سبحانه، وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصاحف، فجاؤوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف، ويتنـزه عنها كلام البلغاء، فضلا عن كلام الرب، سبحانه، حتى أفردوا ذلك بالتصنيف، وجعلوها المقصد الأهم من التأليف، كما فعله البقاعي في تفسيره حسبما ذكر في خطبته".
وقد قال هذا، رحمه الله، بناء على أن الحوادث المقتضية لنـزول القرآن متخالفة باعتبار نفسها، وحتى لا يتقرر عند المرء بأنه لا يكون القرآن بليغا معجزا إلا إذا ظهر الوجه المقتضي للمناسبة وتبَيَّن الأمر الموجب للارتباط.
وعلى كل؛ فإن كلامه غير صحيح، ولم يقنع به أحد من معاصريه أو الدارسين المختصين، لذلك لم يلتفتوا إليه، بل رأوا خلافه.
ومما يحسن التنويه به في هذا المقام نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني، رحمه الله، التي عبر عنها في كتابه النفيس "دلائل الإعجاز"، فهي خطوة واسعة إلى دراسة الأسلوب والنظم القرآني في إطار السياقات العامة بعيدا عن النظرة الجزئية للكلمات واللطائف والنكت التي يتصيدها كثير من السالفين والخالفين.
وبعد؛ فإن القيمة العلمية والعملية في اعتبار السياق عند فهم النصوص الشرعية تظهر جلية في جانبها العلمي والفكري في ترسيخ معانى الاعتدال والمرونة التي تتميز بهما الشريعة الإسلامية، وفي جانبها العملي في تحقيق سلامة العمل بالأحكام المستنبطة من تلك النصوص، وإنه بالرغم من أهمية هذا الموضوع؛ فإنه لم يحظ حتى الآن بعناية كافية في ميدان الدراسات الإسلامية وفقهيات اللغة، اللهم إلا بعض الجهود العلمية المحدودة.
الهوامش :
1 . السورة نفسها:210.2. أخرجه البخاري في صحيحه10/553،باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه،ح:6145.3. 19/147.4. أخرجه مسلم في صحيحه4/1844،في كتاب الفضائل،ح:2373.5. 4/309.6. 3/2257. ص:221-222.8. ص:134.9. ينظر: "البلبل في أصول الفقه" للطوفي ص: 179.10. 4/28911. 10/79-8012. "إعلام الموقعين" 3/100.13. ص:185.14. 1/240.15. مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص: 253.16. أخرجه البخاري في صحيحه(11/146-مع الفتح)،في كتاب الأحكام،باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان،ح: 7158 بلفظ مثله.17. ص:51.18. 2/200 ، نقلا عن بدائع الفوائد لابن القيم: 4/9-10.19. ينظر:الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: 4/192-193.20. اللغة العربية: معناها ومبناها ص:165.21. " مقدمة أصول التفسير" ص: 79 وما بعدها.22. 2/327-32823. ينظر: "البرهان" للزركشي: 1/36.24. ينظر: المصدر نفسه: 1/36.25. 2/138.26. "الإتقان" 4/198.27. 1/34.28. ينظر:"البرهان" 1/37.29. البرهان: 1/37.30. 7/125.31. 1/72 وما بعدها.المصدر : الرابطة المحمدية للعلماء