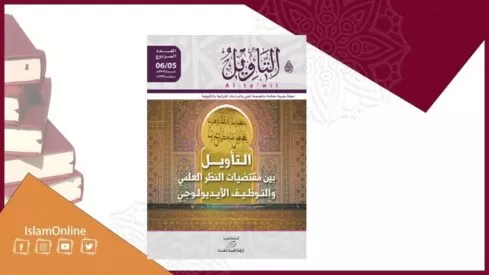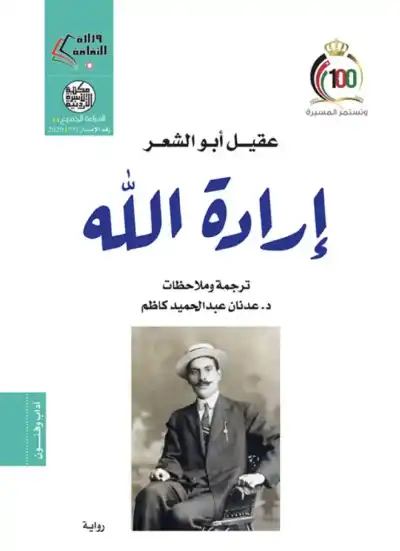مدار الساعة - حين يغيب الاستفهام يغيب المنهج، فالتساؤل ضرورة لإيجاد المنهج وبنائه، والأسئلة الكبرى، لا يمكن أن تكون الإجابة عنها دقيقة ناجزة إذا لم تُحدد الغايات التي ينبغي أن تُؤطر المعرفة، ومن خصائص القرآن الكريم، أنه كاشف للحياة وللأحياء، وللحقائق التي يكون الإنسان مستعدا لكشفها، وهناك قوة معرفية مكتنزة في القرآن يحتاجها الناس والزمان على تعاقبهم، ولكن بحسب قوة الاستمداد منه، وهو استمداد له آدابه وقواعده، ويذهب المفسر الأندلسي "ابن عطية" في كتابه "المحرر الوجيز" أن القرآن الكريم يتنزل بحسب تطلب المخلوق وواقعه.
وفي هذا الإطار يأتي صدور العدد الخامس والسادس من مجلة "التأويــل" يونيو 2020، يقع العدد في 350 صفحة، وهي مجلة علمية محكمة متخصصة في الدراسات القرآنية والتأويلية، صادرة عن الرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب، ويتناول الملف الحالي"التأويل بين مقتضيات النظر العلمي والتوظيف الأيديولوجي"، ويهدف إلى وضع التوظيفات التأويلية في مجالها التداولي السليم، وفي سياق مقاصدها الصحيحة، لإنتاج معرفة تأويلية متماسكة، وقراءة وظيفية نافعة، واستيعاب الكسب الإنساني المعاصر في مجال المنهجيات التأويلية.
التأويل ضرورة
النصوص المؤسسة في الإسلام من قرآن وسنة نبوية وأقوال للصحابة تزيد على ثمانين ألف نص، منها: (6236) آية في القرآن، وحوالي (40) ألف حديث، وحوالي (27) ألفا من أقوال الصحابة والتابعين.والنصوص تحتاج إلى مناهج وآليات ومعارف لاستنطاقها، والتأويل أحد آليات فهم النص، التي أثيرت من قديم، في زمن النبوة وما تبعه من فترات، وكانت اللغة هي المرجع الأول لكل الاتجاهات لتأسيس قواعد فهم النص الديني وتأويله.
والتأويل مرتبط بالموضوع الديني، يقول الراغب الأصفهاني:"والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الإلهية" ووردت الكلمة في القرآن الكريم (16) مرة، وذهب بعض المفسرين أنها تعني التفسير، غير أن الكثير يرون اختلافا بينهما، فالتأويل مرتبط بالمعاني، لذا قال الفقيه الشافعي "الزركشي": "التأويل كشف ما انغلق من المعنى"، لذا فهو منصرف إلى إعمال العقل والاجتهاد في استنباط المعاني والأحكام من النصوص، أما التفسير فيتعلق بالرواية التي تقابل الدراية، ومن ثم فالتأويل أعم وأشمل من التفسير، يقول الإمام "السيوطي":"التفسير يتعلق بالرواية، والتأويل يتعلق بالدراية"، ويذهب الإمام "الشوكاني" في تعريفه للتأويل في إصطلاح الأصوليين بأنه: "صرف الكلام عن ظاهره على معنى يحتمله، وفي الاصطلاح حمل الظاهر على المحتمل المرجوح".
وقد عرف التاريخ الإسلامي نوعا من التحفظ على التأويل، فالتأويل جاء في بعض الحالات بصيغة المنع، كما في قوله تعالى: "فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ"[1].
والتأويل من المفاهيم التي تجاذبتها حقول معرفية عديدة، منها: التفسير، والأصول، والفقه، والحديث، واللغة، والصوفية، والفلاسفة والمتكلمين، باعتباره من المداخل الأساسية لاستئناف حركة الأمة في الاجتهاد والاستدلال؛ والفهم والتنزيل، والإفادة من إمكانات القرآن، بما ينسجم ومقومات التصور الإسلامي المعرفية، وخصوصية القرآن الكريم.
كان الإمام "الشافعي" من أوائل من تكلم في المفهوم عند الأصوليين في كتابه "الرسالة" حيث ورد المصطلح ثمانية مرات، ثم أخذ التأويل نفساً جديداً عند اللغوي "أبوعبيدة معمر بن المثنى" ( المتوفى 209 هـ) في كتابه "مجاز القرآن" حيث سعى لإخراج معنى الآيات عن دلالتها الموهمة بالتشبيه والتجسيد للخالق سبحانه وتعالى، كما نضج إشكال التأويل في بيئة أهل الكلام والفلسفة، في سياق الاختلاف حول العلاقة بين العقل والنقل، وأيهما يُقدم على الآخر، وأيهما أساس للآخر.
وقد حث الواقع الفكري الذي نشأت فيه العلوم الإسلامية، طائفة من العلماء من مختلف الفرق والمذاهب، إلى الكتابة في موضوع "قانون التأويل" منطلقهم في ذلك أن النظر التأويلي، يقتضي وضع آليات، ومحددات، وقوانين تجعل المرور من النص إلى الواقع، عملية لها شروط تؤطرها، وضوابط تَحكُمها.
وكان للفيلسوف "ابن رشد" إسهام كبير في موضوع التأويل وأهدافه ومنهجه، في كتابه "فصل المقال"؛ فجاء أحد فصول كتابه بعنوان "قانون التأويل"، على اعتبار أن هناك قوانين عامة للعقل والمنطق في تلقي المعرفة، وبذلك وضع المعالم الكبرى للعملية التأويلية حتى لا تضل، فالتأويل عنده ليس كشفا إلهيا، ولكنه منهج عقلي واستدلال منطقي، وتحليل للتجارب الحية وإدراك للواقع.
وألف الإمام أبو حامد الغزالي رسالة بعنوان "قانون التأويل"، وكان له ثلاث وصايا علمية في الموضوع، هي:
-عدم الطمع فيما لا يُتبنى فيه وجه التأويل أصلا، مثل الحروف المذكورة في فواتح السور طالما لم يصحّ فيها معنى بالنقل، ورأى أنه لا محالة للمؤول حتى يكون منطلقه ومنتهاه سليما، من الاعتراف بأن علم الإنسان سيظل قاصرا مهما علَت مرتبته.
– ألا يكذب برهان العقل أصلا، فإن العقل لا يكذب فبه عرفنا الشرع، فهو يرى أن "العقل مزكى الشرع ".
-أن يكف عن تعيين التأويل عند تعارض الاحتمالات، ويقول في ذلك :"ولست أرى أن أحكم بالتخمين، وهذا أصوب وأسلم عند كل عاقل، وأقرب إلى الأمن في القيامة".
ووضع أبو بكر بن العربي المعافري (ت 543 هـ) كتابا بعنوان "قانون التأويل"، واجتهد أبو الحسن علي بن أحمد التجيبي الحرَالِّ المراكشي (ت :638 هـ) في تأسيس قوانين تنزل في فهم القرآن منزلة أصول الفقه، وجعلها موضوع رسالته الأولى "مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل" .
توظيف التأويل
التأويل نهج سليم للتعرف على الحقائق وإدراك المعاني، ولعبت الأفكار المسبقة والمذهبيات دورا في التوسل بالتأويل للحديث عن أفكارها، فالمعتزلة سعت أن تجعل التأويل قانوناً يرجع إليه، وقامت فرقا أخرى بافتعال تعارض متوهم بين الوحي والعقل.وفي الوقت الراهن أصبح التأويل محركا لكثير من العلوم الإنسانية والاجتماعية واللسانيات، وفي مجال الدراسات القرآنية توسلت بعض الأفكار بالتأويل للنيل من النص القرآني، كما جاء في بعض مشاريع القراءات الحداثية للقرآن الكريم التي تعرضت لها المجلة، مثل "حسن حنفي" الذي تحدث عن "مادية" الوحي، واستقلاليته عن الخالق سبحانه وتعالى، وأن مهمته ووظيفته تربية الإنسان وليس هدايته، بل يمضي في أوهامه أبعد من ذلك زاعما وجود تداخل بين كلام الخالق سبحانه وبين كلام البشر في القرآن، وبالتالي-حسب زعمه- يوجد صعوبة في التمييز بين ما هو إلهي وما هو بشري في القرآن الكريم، أما "طيب تيزيني" فدعا إلى إعادة قراءة النصّ القرآني وتأويله وفق ما يتماشى مع العصر وإن اقتضى الأمر تعطيل بعض الآيات والأحكام، كما شكك في إعجاز القرآن، وزعم وجود تناقض في القرآن.
كتاب المعافري ورسالة الغزالي بنفس العنوان "قانون التأويل"وهنا تبرز حتمية إعادة بناء قانون للتأويل، يجعل النص المؤسِّس في منأى عن أن يكون مجالً للمزايدات والإقحام المغرض، أو العبث بقطعيات النصوص قبل ظنياتها، قانون يمكِّن من الفهم الصحيح لمقاصد الدين وغاياته العليا، الأمر الذي يبرز أهمية التشديد على استعادة ضرورة بناء قوانين للتأويل من الواجب مراعاتها، ومن الأفكار التي وردت على صفحات المجلة، ضوابط التأويل المقاصدي، ومنها:– وجود داع للتأويل، كأن يكون هناك تعارض بين نصين، فيكون التأويل هنا من أجل دفع التعارض.
– أن يكون التأويل جارياً على قواعد اللسان العربي وضعاً واستعمالاً.
-ضرورة الاعتماد على أقوال المتكلم لفهم كلامه فلا يصح العدول عنها وإهمال استقراء النصوص الأخرى، يقول الإمام الغزالي:"كل تأويل يرفع النص أو شيئاً منه فهو باطل" إذ لا اجتهاد في مورد النص، فما أُجمل في مكان فُصل في آخر، وما أُطلق في مكان قُيد في مكان آخر.
-إذا لم يُوجد نص مفصل، وجب اختيار أليق المعاني المناسبة للمقام، ممّا ينسجم مع المقررات الأصلية للشريعة الإسلامية وأصول الدين وقواطع العقول.
-لا يُجمع بين متفرق، ولا يُفرق بين مجتمع.
-لا تأويل إلا بدليل معتبر من العقل والنقل، وما لم يقم عليه دليل فهو التأويل المستكره الذي يستبشع إذا عرض على الحجة، وقسم الراغب الأصفهاني التأويل على قسمين: تأويل منقاد، وتأويل مستكره، وعرف التأويل المنقاد بأنه الذي لا يجافي منطق اللغة ولا ينأى عن دلالتها، أما المستكره فهو الذي يلوي فيه المفسر أو المؤول النص حتى يوافق هواه ويسير مع رغباته ويدعم مذاهبه واتجاهاته.
-لا يجوز التأويل نصرة للمذهب؛ لأن القرآن حاكم ومهيمن، والتعارض بين نصوص الشريعة والمذهب، يفرض تعديل المذهب ليوافق الشريعة لا العكس.
[1] سورة آل عمران: الآية :7