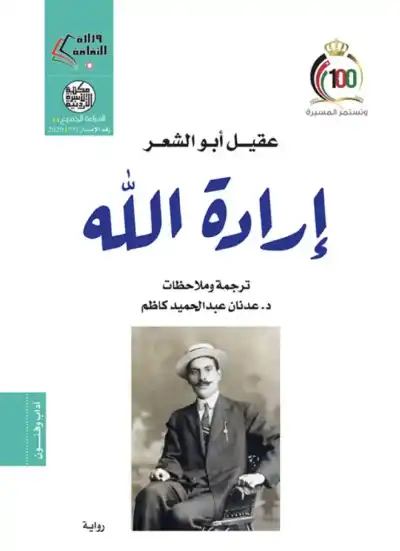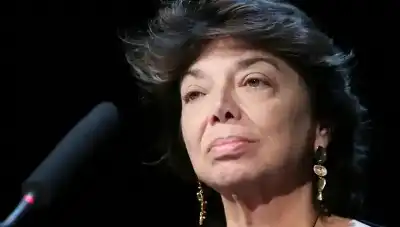مدار الساعة - استعاد المغرب خلال الأسبوع المنصرم ما يفوق 25 ألف قطعة أثرية نادرة، تزن ثلاثة أطنان، كانت قد صادرتها السلطات الفرنسية على أرضها في عام 2006، بعدما هربها من البلاد مجموعة مغاربة يقودون سيارات فارهة.
وتشمل هذه القطع الثمينة فكوك حيوانات قديمة، وأدوات بدائية، ونقوشًا صخرية، وتماثيل، ونيازك، وحفريات تعود لملايين السنين. ولحسن الحظ أن هذه الآثار المهربة لم تصل هذه المرة إلى المتاحف الأجنبية، لكن يبقى السؤال كيف خرجت كل هذه الكمية الكبيرة من الآثار من البلاد؟ هذا ما نتناوله في السطور التالية.
تقتات على كنوز الوطن.. مافيا الآثار تهرب كل ما يمكن تهريبه
في الواقع تهريب الآثار في المغرب يسير على قدم وساق منذ عقود، فهناك دومًا مافيا نافذة، مستعدة لعرض تاريخ شعب بأكمله في المزاد العلني مقابل المال، وتستخدم من أجل الوصول لمبتغاها كل الحيل القانونية وغير القانونية.
تُهرب هذه المافيات كل أنواع الآثار الموجودة، بغض النظر عن قيمتها أو حجمها، بدءًا من الصكوك والمخطوطات والأدوات القديمة، والمستحاثات والحفريات والمنحوتات، وصولًا إلى هياكل الديناصورات الكبيرة، مثلما حدث عام 2017 عندما عُرض هيكل ديناصور بحري (بليسيوصور) عاش قبل 66 مليون سنة، للبيع في فرنسا، وسرعان ما تبين تهريبه من المغرب.
تعمل غالبًا عصابات الآثار المحلية مع وسطاء وسماسرة، يتوجهون إلى البازارات والمواقع الأثرية والخزانات القديمة والقصبات، للتنقيب عن القطع الأثرية التي قد تكون ذات قيمة مالية، بعد أن يحصلوا عليها إما عن طريق النهب المباشر، وإما الرشوة وإما الشراء، ثم يهربونها خارج حدود البلاد لبيعها إلى وسطاء دوليين، يبيعونها بدورهم إلى المتاحف العالمية أو مزادات.
وفي هذا الإطار، تحوَّلت جهة درعة تافيلالت، الزاخرة بالقرى القديمة والقصبات التاريخية والمساجد العتيقة، إلى قبلة لمهربي الآثار، حيث يسهل هناك الحصول على القطع الأثرية النفيسة، في غفلة من السكان الذين يعيش عمومهم فقرًا مدقعًا. وبمجرد الحصول عليها تستقدم إلى مدينة مراكش السياحية لعرضها بالبازارات، وأحيانًا يشتريها سياح أجانب، وأحيانًا أخرى تبتاعها عصابات الآثار لتهربها خارج الحدود. وتقدر بعض وسائل الإعلام تجارة الآثار في المغرب بحوالي 40 ميون دولار سنويًّا.
ورصدت مجلة «فوربس» الأمريكية تزايد التجارة في الآثار المهربة خلال الفترة الأخيرة؛ إذ قالت إن اللصوص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستفيدون من عمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا، لنهب المواقع الأثرية وبيع اكتشافاتهم في السوق السوداء عبر الإنترنت.
وذكرت المجلة أن آثارًا مسروقة من مسجد قديم بالقرب من مدينة العرائش المغربية، عرضت صورها على صفحة «فيسبوك» خاصة بتجارة الآثار، ويَعتقد المراقبون أن المصاعب الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا، ستؤدي إلى زيادة الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك نهب القطع الأثرية.
عانت دول أفريقية مثل الجزائر ومصر والمغرب وتونس، على مدى عقود، من مزيج سام من الاضطرابات الاجتماعية المتكررة والفساد المتصاعد، وسوء الإدارة. وقد أدى ذلك إلى خلق ظروف مواتية لظهور أسواق غير مشروعة، وترعرع الجرائم المنظمة مثل الاتجار بالآثار والتحف الثقافية في المنطقة.
ويساهم الفساد وغياب البدائل الاقتصادية في نمو شبكات التهريب، التي تزدهر في المناطق الحدودية؛ إذ تخلق شبكات التجارة غير المشروعة خيارات وفرص عمل لسكان الحدود، وترشي بعض موظفي السلطات برشى مغرية لغض الطرف، مما يجعل مكافحتها أكثر صعوبة.
من جانب آخر، يلعب ضعف الوعي العام بالقيمة التاريخية للآثار دورًا في إهمال التراث الأثري بالمغرب وتهريبه، ونتيجة لذلك لا توجد في البلد البنية التحتية الكافية في هذا المجال، من متاحف ومختبرات وخزانات محتويات فريدة، والتي من شأنها استقطاب جمهور، وبالتالي دعم أسواق محلية للمعروضات الفنية الثقافية، وهو ما كان يصب في ضياع حفظ الذاكرة التاريخية في نهاية المطاف.
ويزيد الجهل الشعبي بالآثار الأمر سوءًا ويعرضها للإهمال والتخريب، على سبيل المثال، تنتشر في عمليات الحفر السرية التي يقوم بها الباحثون عن الكنوز، وهي مشكلة أخرى تخرب المواقع التاريخية والأثرية. «وثقافة الكنازة» هي ممارسة قديمة جدًّا في المغرب تعود إلى العصور الوسطى على الأقل، وما تزال إلى اليوم متجذرة في المعتقدات الشعبية. والمحصلة بعد عقود من تهريب الآثار في المغرب؛ هي تدمير الهوية الحضارية، فضلًا عن إضعاف البحث العلمي، بعد إفراغ البلاد من ممتلكات فنية وثقافية وتخريب مواقع أثرية لا تقدر بثمن.
كيف يمكن القضاء على تهريب الآثار المغربية؟
نظريًّا، لا يمكن لأي تحفة أثرية أن تخرج من أرض الوطن دون تصريح رسمي، وينص القانون 22-80، المتعلق بالحفاظ على المعالم والمواقع التاريخية والنقوش والأعمال الفنية والآثار، على تجريم «تدمير أو تشويه أو تصدير دون ترخيص أي قطعة فنية وأثرية متحركة تقدم للمغرب مصلحة تاريخية وأثرية وأنثروبولوجية، أو مثيرة للاهتمام في علوم التاريخ والعلوم الإنسانية بشكل عام».
لكن هذا لا يمنع عصابات تهريب الآثار من ممارسة نشاطها بأمان؛ إذ تستطيع تأمين عملياتها من خلال المال والنفوذ، وتقوم بعمليات تهريب كبيرة لأطنان من الآثار، وهياكل ديناصورات ضخمة، ولا يكتشف المغرب حوادث تهريبها إلا بعد عرضها في المتاحف العالمية، أو حجزها من قبل سلطات تلك البلدان الأجنبية.
وفي هذا الصدد، يرى هشام الداودي، رئيس الجمعية المغربية للأعمال والأشياء الفنية، أنه من الضروري «الإسراع في إنشاء شرطة خاصة لحماية الممتلكات الثقافية، وملاحقة كل من يخرب أو يهرب تراثًا أثريًّا، ويطبق عليه القانون دون تمييز»، كما يحث على إنشاء نظام تسجيل للقطع الأثرية، بحيث يعرف أصلها وخصائصها، مما سيسهل تتبعها في حال فُقدت.
ويدعو الناشط الثقافي أيضًا إلى إجراء تحقيقات لجرد كل الآثار التي اختفت أو سرقت لمدة قرن تقريبًا، ثم بعد ذلك الشروع في البحث عنها بغرض استردادها، دون انتظار انكشافها بالصدفة عبر الإعلام الأجنبي.
لكن، وحسب المراقبين، لا ينبغي أن تقتصر الجهود المبذولة، للقضاء على التجارة غير المشروعة، على تعزيز أمن الحدود والتشديد القانوني، بل بالأحرى، يجب معالجة الأسباب الجذرية للظاهرة، وهي الفساد وغياب البدائل الاقتصادية وضعف الوعي العام بتقدير الآثار؛ هكذا يمكن تعزيز الهوية التاريخية للمغرب، وحماية تراثه الثقافي من بائعي الوطن في المزادات العلنية.