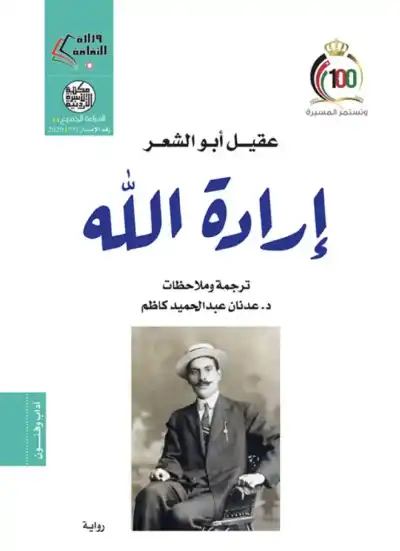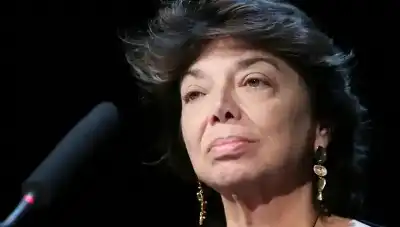مدار الساعة - يبدو أن الجيل الجديد من ألعاب الفيديو والإنترنت قد جاوز حد التسلية، ليزج بناشئتنا في اغتراب ثلاثي الأبعاد، وليضع الأسرة والمدرسة والأجهزة الرقابية في كل بلد عربي أمام تحدٍ ينبغي كسبه بأي حال من الأحوال.
إذ حين تتحول التسلية الإلكترونية إلى نسق ثقافي مرعب يُجرد الطفل من انتمائه، ويخلق هوة بينه وبين واقعه، ثم يُغريه بالذوبان في هوية الآخر ومعتقده وقيمه، فإن التصدي الحازم، وتقوية الجهاز المناعي للأمة ينبغي أن يحتل الصدارة في سلم الأولويات كضرورة حضارية.
إن جولة قصيرة في محلات الألعاب الإلكترونية، أو استعراضا سريعاً لألعاب الإنترنت التي تحظى بإقبال كثيف من لدن الصغار، كفيلان بتشكيل قناعة مفادها أننا بتنا نواجه هيمنة ذكية ومدمرة، وأن الاستعلاء الثقافي المدعوم باستبداد تقني، هو ديدن الغرب في علاقته بالعالم الإسلامي، رغم كل دعاوى احترام الخصوصية والحق في الاختلاف، فالعوالم الافتراضية التي تؤسس لها الألعاب الالكترونية الحديثة، لا تروم فقط توفير المتعة والفرجة وتنشيط قوى الخيال كما يُروج لها، بقدر ما تعمل على تغذية العقول بقيم وتمثلات تزعزع العقيدة، وتُشكك في الثوابت، وتعيد تشكيل السلوك، بما يمنح للتغريب والتنميط مشروعية ووجاهة إزاء الوضع الذي تعيشه الأمة الإسلامية؛ بمعنى أن ينحاز الجيل القادم لمنظومة بديلة تُجرده من كل مظاهر الانتماء لدينه وتاريخه وهويته.
إذا كان التلفاز يمنح للطفل فرصة المشاهدة فقط، فإن ألعاب الفيديو الحديثة أتاحت له إمكانية التحكم فيما يُشاهده، وحرية التصرف وإدارة العالم الافتراضي الذي ينجذب إليه بقوة، وبالتالي فإن عدد ساعات لعبه يتضاعف كلما طُرحت في الأسواق نسخة مطورة من لعبته، أو حينما يُمكنه الموقع الالكتروني للعبة من الانتقال إلى طور جديد يتسع فيه هامش حريته وتصرفه، وتتزايد فيه المغريات وحظوظ النجاح!
فقد كشفت دراسة أجراها المعهد الوطني للإعلام والعائلة بجامعة "أيوا" الأمريكية أن معدل ساعات اللعب لدى الفتيان يصل إلى 4-16 ساعة في الأسبوع، ولدى الفتيات إلى 2-9 ساعات، وأن المعدل قد يصل إلى 24 ساعة -أي حوالي ثلاث ساعات ونصف يومياً- لدى الأطفال الذين بدت عليهم مؤشرات الإدمان المرضي للتسلية الإلكترونية، وفي المقابل يتخلى الطفل عن هواياته الأخرى، وعن متعة اللعب والتفاعل مع أترابه، وبالتالي عن المواقف التربوية والاجتماعية التي تغذي قدرته على الحوار وحل المشكلات، فأسلوب اللعب المنفرد الذي يعتمده مصممو هذه الألعاب يُعزز من انطوائية الطفل وانكفائه على نفسه، خصوصاً في مرحلة البلوغ التي من أهم سماتها:
ميله للانعزال، وانسحابه من جماعة الأصدقاء (1). زد على ذلك ما تضج به البيئة العربية من أساليب التربية الخاطئة، ومظاهر العجز عن التعاطي الإيجابي مع التغيرات المصاحبة لدورة النمو النفسي!
إن اعتماد ألعاب الفيديو على الجاذبية الآسرة للصورة، وسعيها للالتصاق بالواقع، يُمَكِّنُها أن تشغل حيزاً مهما من نشاط الطفل الخيالي، وبالتالي العبث بتمثلاته وأفكاره ومواقفه، ذلك أن الاستغراق الدائم في اللعب يُوهمه بانتفاء الحيز الفاصل بين واقعه العملي والافتراضي، يقول الدكتور فرانك كيلش: "إن الهدف الرئيسي من كل لعبة هو أن يدخل في روع المشاهد نوعاً من المصداقية ولو إلى حين. وعندما تأسر اللعبة لب اللاعب للدرجة التي قد ينسى نفسه تماماً في خضم أحداثها، فإن جزءاً من تجربة اللعبة نفسها، وهو الشعور بعدم المصداقية، يكون في تلك اللحظة مرجئاً، وهكذا تجر اللعبة لاعبها إلى النقطة التي تصبح فيها حقيقة"(2).
وحين يلتفت الطفل إلى واقعه بحثاً عما يُطابق ما انغرس في مخيلته من رسائل وتمثلات جراء اللعب، لا يجد شيئاً من ذلك، فيؤثر الانسحاب من واقعه، وتغليف ذاته بأحاسيس الغربة والانسلاخ، بل وصل الأمر اليوم إلى التعبير عن عدم الانتماء للمجتمع واللغة ومنظومة القيم الحارسة للهوية والدين!
عندما نتفحص الرسائل المبثوثة عبر الآلاف من هذه الألعاب الحديثة نخلص إلى أننا أمام قصف ممنهج لا يستهدف الأبنية أو المنشآت، بل يروم وبكل قسوة تحطيم البراءة الطفولية، وحرمان الأمة من خزان وقودها الذي تراهن عليه لاستكمال بنائها الحضاري، لذا فالوقائية، باعتبارها مبدأً أصيلاً في المنهج التربوي الإسلامي، تُلزم القائمين على الشأن الأسري والتربوي بالمبادرة للحد من الآثار الضارة للتسلية الإلكترونية، لا من خلال تكثيف الرقابة الأسرية والرسمية فقط، بل كذلك بتوفير البدائل، وتوجيه اهتمام الأطفال للتسلية التي تجمع بين المتعة والجدة والإفادة.
1- د. شحاتة محروس طه: أبناؤنا في مرحلة البلوغ وما بعدها. وحدة ثقافة الطفل بشركة سفير. د. ت. ص 12.2- د. فرانك كيلش: ثورة الأنفوميديا. المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب. الكويت 2000. ص 161